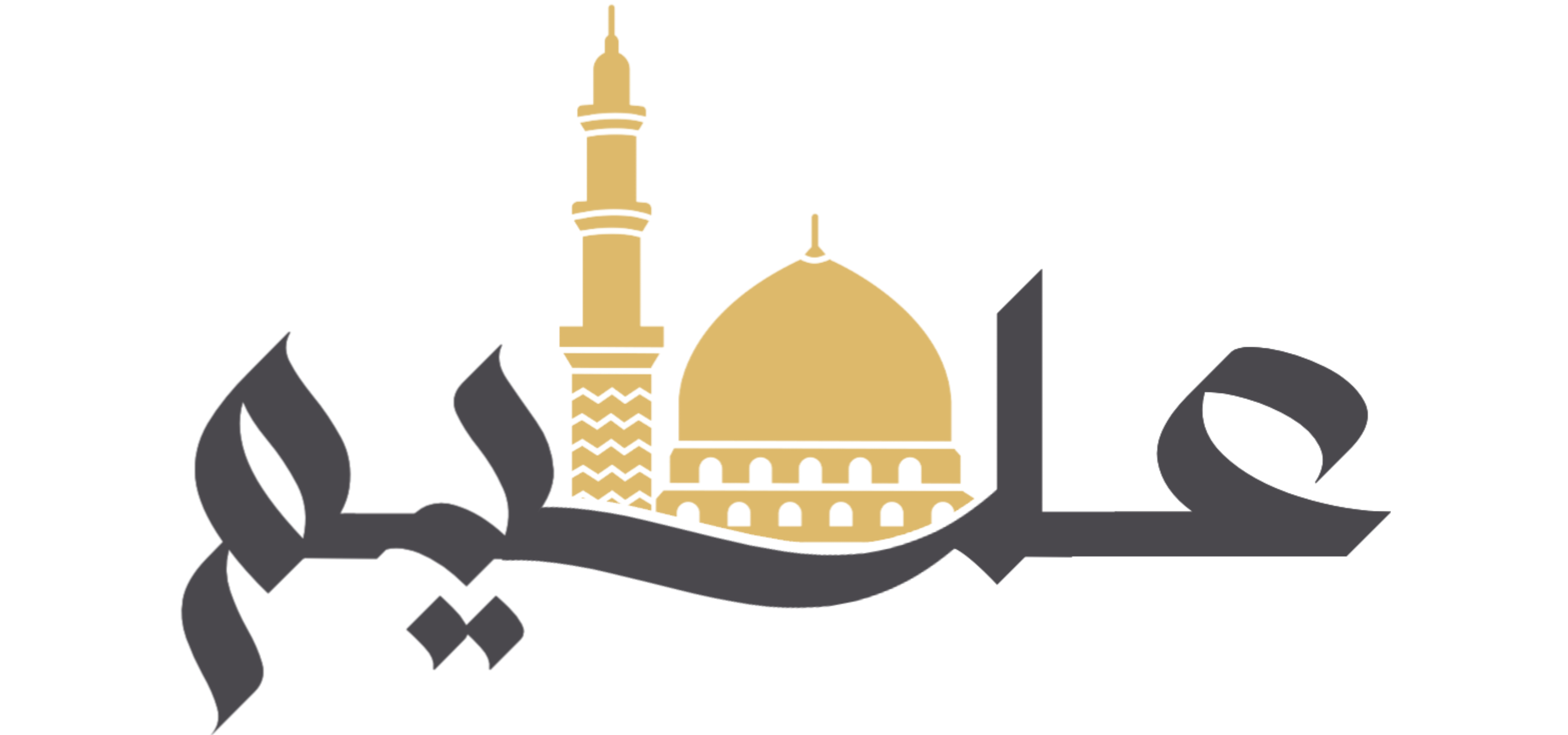اختِيرَتْ مكةُ المكرمة في عام 1426هـ/2005م من قِبَل المنظَّمة الإسلاميَّة للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) – عاصمةً للثقافة الإسلاميَّة، فهل هذا التكريم لمكة أم للمنظَّمة؟
لا شكَّ في أنَّ للمنظَّمة الإسلاميَّة (إيسيسكو) المعنيَّة برُقِيِّ وتَطوِير المدينة الإسلامية، وفقَ رُؤى وخصوصيَّة إسلاميَّة شفَّافة – جهودًا محمودة لا تُنكَر، إلاَّ أنَّ السؤال الذي يَطرَح نفسه هنا: هل مكة المكرمة تحتاج إلى وسامٍ قد لا يجد له متَّسعًا على صدرها المثقل بالأوسمة والنياشين الدينيَّة والدنيويَّة؟ لعلَّ المنظمة الإسلامية – في هذا المقام – هي مَن تحتاج إلى وسامٍ من مكة المكرَّمة تضعه على صدرها في يوم الفخار؛ لكونها المدينة المقدسة العتيقة التي اختارها الله – جلَّ جلاله – لأوَّل بيتٍ جعَلَه للنَّاس مثابةً وآمنًا؛
﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا البَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا ﴾
[البقرة: 125]
حقًّا مَن يُكرِّم مَن؟!
فحسب مكَّة أنَّ من رَحِمِها خلق الله الأرض ومنها دُحيت، وكعبتها المشرَّفة التي تقع في وسط العالم هي سُرَّة الأرْض ومركزُها، هذا يعني: أنَّ مكَّة هي أُمُّ الدُّنيا بحواضرها ومدنها وقراها وكل معمور منها، والعاصمة العالميَّة للأرض، وهي بالتَّالي أم الثقافات الإنسانية جميعًا، هي بَحرها ومحيطها، ضحى شمسها وقمر ليلها، نجوم سمائها وأبجديَّة أرضها، والثَّقافة بكلِّ ما تَعنِيه الكلمة من إرثٍ حضاري تراثي معنوي ومادي بدَأت خُطاها الأولى من مكَّة، وآية ذلك كلِّه ما تشهد به المأثورات التاريخيَّة القديمة القائلة بأنَّ أبانا آدم – عليه السلام – يومَ هبط الأرض خارجًا من الجنَّة، تملَّكه خوفٌ شديد، فرَفَع بصرَه إلى السَّماء وتوسَّل إلى ربِّه قائلاً: ربِّ ما لي لا أسمع صوت الملائكة ولا أحسُّ بهم؟! فكان الجواب: “إنَّها خطيئتُك يا آدم… اذهب وابنِ لي بيتًا، وطُفْ به، واذكرني حولَه، فطَفِق يبحَث عن مكانٍ يَبنِي فيه الذي أمَرَه ربُّه أن يبنيه، فانتَهَى به المطاف إلى وادي مكَّة، وبنى البيت العتيق، الذي أصبَحَ منذ ذلك الزَّمن وإلى يومنا هذا وحتَّى يرث الله الأرض وما عليها، مكانًا مباركًا يحجُّ إليه النَّاس من كلِّ فجٍّ عميق؛ طلبًا للرَّحمة والغفران.
إقرأ أيضا:مكة في العصر الأمويأوَّلاً – مكَّة المكرمة:
1/1 – الجذور التَّاريخيَّة – قداسة المكان والزَّمان:
تذهَب الرِّوايات التي تتحدَّث عن الجذور التاريخيَّة لمكَّة إلى أبعد من ذلك؛ فتذكر أنَّ الملائكة هم الذين بنَوْا بيت الله في هذا الموقع (مركز الأرض)؛ لتكون مَزارًا ومَطافًا لهم فيه، لا جرم أنَّ مكَّة المكرَّمة تعدُّ واحدة من أعظم وأكثر مدن الأرض وعواصمها مكانةً وشهرة، ولم تَحْظَ أيُّ مدينةٍ في العالم بِمثل ما حَظِيَتْ به مكَّة من تكريم، ويَكفِيها أنَّ الله بارَكَها وجعَلَها أوَّل مكانٍ يُعبَد فيه من أبي البشَر آدم – عليه السلام – من ثَمَّ آثَرَها – جلَّ وعلا – على غيرها من بِقاع العالم طهرًا وقدسية، وجعَلَها بعد حينٍ من الدَّهر، قبلةً للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، بعد أنْ أوحى الله لسيِّدنا إبراهيم وابنه إسماعيل – عليهما السلام – أن يُقِيمَا بِناءَ البيت مرَّة ثانية؛
﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴾
[آل عمران: 96].
مهْما اختَلَف المؤرِّخون والرُّواة وأهل العلم والدين حولَ تاريخ ظهور مكَّة إلى الوجود، يَبقَى هناك اتِّفاق بينهم على أنَّ مكَّة المكرَّمة ليست عريقةً في القِدَم فحسب، بل من أقْدم مدن المعمورة – ما كان معلومًا منها ومجهولاً – وأنَّ البيت الحرام الَّذي يعدُّ اليوم واحدًا من أعظم المساجد وأكبر دُورِ العبادة على وجه الأرض – هو أوَّل بيت وُضِع لأهْل الأرض ليَعبُدوا الله – عزَّ وجلَّ – فيه، وليهتَدُوا بفضله إلى صراط الحقِّ، الصراط المستقيم، وأنَّ واضِعَ حجر الأساس لمدينة مكَّة الصغرى هو النَّبي إبراهيم – عليه السلام – لتُصبِح مدينةً مأهولة في عهد قُصَي بن كلاب بن مرَّة بن كعْب بن لؤيّ، وفي عهد قُصَيٍّ شهدت مكَّة تَوسِعة كبيرة، وعُنِي بتنظيمها خيرَ عناية، حتَّى أضحت في زمانه مدينةً عامرة مستطيلة المساحة ذات شعاب واسعة.
إقرأ أيضا:حرمة مكة المكرمة وقداستها2/1 – مكة: موقعًا:
تقع مكَّة المكرَّمة في الجانب الغربي من جزيرة العرب، في بطن وادٍ ضيِّق طويل، من أودِيَة جبال السَّراة، غير ذي زرْع، يسمِّيه المكيُّون وادي إبراهيم، وعمرانها بيوتها منتشرة على امتِداد هذا الوادي على شكل هلالٍ يَمِيل إلى الاستِطالة – حيث يتَّجِه جانباه نحو سفوح جبل قعيقعان غربًا، وجبل أبو قبيس شرقًا، ومن محلَّة المعابدة طولاً إلى محلَّة المسفلة جنوبًا – تُحِيط به الجبال والتلال الجرداء والصخور الصلبة من كلِّ جانب؛ لتشكِّل حول مكَّة وكعبتها دائرة، ومن أضخم جبال مكة وأعظمها أبو قبيس، ويقع إلى الجهة الشَّرقيَّة منها، ويطلُّ على المسجد الحرام، ومن جبالها المعروفة قعيقعان، وفاضح، والمحصب، وثور، والحجون، وحراء، وتفاحة، والفلق.
وكانت المناطق المنخفضة نسبيًّا من ساحة مكَّة تسمَّى البطحاء، وكلُّ ما نزَل عن الحرم المكي يسمُّونه “المسفلة”، وما ارتَفَع عنه يسمُّونه “المعلاة”، ومكَّة تقع عند خط تقاطع درجتي العرض 21/28 شمالاً، والطول 37/54 شرقًا، وترتَفِع عن سطح البحر بنحو 280مترًا، هذا يعني أنَّها تقع ضمن سهل تهامة السَّاحلي الذي يمتدُّ على طول ساحل البحر الأحْمر من أقصى شماله عند خليج العقبة إلى نهايته الجنوبيَّة عند باب المندب، أضِف إلى ذلك أنَّها تمثِّل نقطةَ التِقاء بين تهامة وجبال السروات.
3/1 – مكَّة: مناخًا:
أمَّا مناخ مكَّة وجَوُّها فهو حارٌّ جافٌّ، تَتفاوَت حرارته بين 18 درجة في شهور الشِّتاء وبين 30 درجة إلى ما يَزيد على 40 درجة في شهور الصيف، حيث ترتَفِع الحرارة فيها ارتِفاعًا شديدًا، وتكون دافئة في الشتاء؛ لوقوعها ضمنَ المنطقة المداريَّة الشماليَّة، ولتأثيرات مناخ البحر المتوسط والمناخ الموْسمي الانتِقالي وتأثير البحر الأحمر على مناخها نسبيًّا، رياحها في الشتاء شماليَّة غربيَّة وفي الصيف شماليَّة شرقيَّة جافَّة، ولموقع مكَّة في وادٍ غير ذي زرعٍ لجأ أهلُها إلى الاعتِماد على غيرهم في حياتهم المعيشيَّة وفي أقواتهم، الطَّائف والسَّراة بخاصَّة.
إقرأ أيضا:مكة منذ أقدم العصور4/1 – مكة: أسماءً:
عُرفت مكة – وللدَّلالة على شرف مسمَّاها وسموِّ مكانتها – بأسماء كثيرة، فمِن أسمائها التي ورَدتْ في القرآن الكريم “مكَّة” و”بكَّة”، و”البلد الأمين”، ومِن أشهر أسمائِها “أم القرى”، ولها أسماء أخرى منها “أم رحم”، و”الحاطمة”؛ لأنَّها تحطم مَن استَخَفَّ بها، و”البيت العتيق”؛ لأنَّه عتق من الجبابرة، و”الرَّأس”؛ لأنَّها مثل رأس الإنسان، و”الحرَم الأمين”، و”القرية”، و”الوادي”، و”البلدة”، و”البلد”، و”معاد”، و”صلاح”، و”العرش”، و”القادس”؛ لأنَّها تقدس من الذنوب؛ أي: تُطهِّر، و”المقدسة”، و”الناسة” و”الباسة” بالباء الموحَّدة لأنَّها تبسُّ؛ أي: تحطم الملحِدين.
ويُروَى أنَّها سميت مكَّة لقلَّة مائها، من قول العرب: “امتَكَّ الفصيل ما في ضرع أمِّه”؛ أي: امتصَّه مصًّا شديدًا.
وقيل أيضًا: لأنَّها تمكُّ الذنوب؛ أي: تذهب بها
وقيل: سميت مكَّة لأنَّها تمكُّ الظَّالم (الجبَّار) فيها؛ أي: تنقصه وتُهلِكُهُ
وقيل: إنَّما سُمِّيت “بكَّة” لأنَّ الأَقدام تَبُكُّ بعضها بعضًا، كذلك لأنَّها تَبُكُّ – أي: تَدُقُّ – عنق الفاجر ورقاب الجبابرة الذين يبغون فيها
وفي اللسان العربي: “مكَّة” هي “بكَّة”، والميم بدلٌ من الباء مثل: “ضربة لازم” و”ضربة لازب”، ورُوِي أنَّ بكَّة موضع البيت، ومكَّة هي الحرم كلّه
وقيل أيضًا: إنَّ بكَّة الكعبة والمسجد، ومكَّة هي ذو طوِيِّ، “الطَّوِيُّ” وهو البئر المطويَّة بالحجارة، (بطن الوادي) بأعلى مكة
وفيه قيل:
إِنَّ الطَّوِيَّ إِذَا ذَكَرْتُمْ مَاءَهَا  صَوْبُ السَّحَابِ عُذُوبَةً وَصَفَاءَ صَوْبُ السَّحَابِ عُذُوبَةً وَصَفَاءَ |
وهناك قول: إنَّ العمالقة عندما سكنوا مكَّة أطلَقُوا عليها اسم “بكا” “بكَّة” وهي كلِمةٌ بابليَّة معناها البيت.
وسمَّاها الله – كما تقدَّم – بـ”أمِّ القرى”، فقال:
﴿ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾
[الأنعام: 92]
وسمَّاها – تعالى – “البلد الأمين” في قولِه – جلَّ وعلا – :
﴿ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ * وَطُورِ سِينِينَ * وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ﴾
[التين: 1 – 3]
وقال – عزَّ مِن قائل – :
﴿ لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ * وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴾
[البلد: 1 – 2]
وقال – عزَّ وجلَّ – :
﴿ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾
[الحج: 29]
وقال – تعالى – :
﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ ﴾
[المائدة: 97]
وقوله – تعالى – على لسان إبراهيم – عليه السلام – :
﴿ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ﴾
[إبراهيم: 35]
وقال – تعالى – أيضًا على لسان إبراهيم – عليه السلام – :
﴿ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ﴾
[إبراهيم: 37]
، ولعلَّ اسم “مكَّة” كان يُعرَف باسم “مكرب”؛ أي: مقدَّس، ثم تحوَّل الاسم إلى مكَّة.
5/1 – مكة: اقتصادًا وثروات:
لا ريب أنَّ العرب حتى في جاهليَّتهم، كانوا يرَوْن مكَّة – منذ نشأتها – بقعةً مقدَّسة، يشدُّون إليها الرِّحال من كلِّ أرجاء جزيرة العرب، كما أنَّ وادي مكَّة احتَفَظ بمكانته الحيويَّة كمحطَّة مهمَّة لمرور قَوافِلهم التجاريَّة – بين اليمن وبلاد الشَّام خاصَّة – وسوق رئيسة لهم لوقوعه وسط الطريق بين شمال الجزيرة العربيَّة وجنوبها من ناحية، فضلاً عن غِناه بعيون الماء الوفيرة الَّتي تحتاج إليها القوافل التجاريَّة في حلها وترْحالها بين اليمن جنوبًا والشام شمالاً من ناحِيَة أخرى.
ومن المعروف أنَّ قريشًا احتَكرَتْ منذ نهاية القرن السَّادس الميلادي، تجارة الهند بفضْل جهود زعيمِها هاشم بن عبدمناف، جَدِّ عبدِالله والد النَّبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – الَّذي يُعَدُّ أوَّل مَن سَنَّ رحلة قريش، (الإيلاف)رحلة الشتاء إلى اليمن (والحبشة والعراق) ورحلة الصَّيف إلى الشَّام،
﴿ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ * إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ * فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ * الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴾
[قريش: 1 – 4].
| يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ المُحَوِّلُ رَحْلَهُ هَلاَّ نَزَلْتَ بِآلِ عَبْدِ مَنَافِ الآخِذُونَ العَهْدَ مِنْ آفَاقِهَا وَالرَّاحِلُونَ لِرِحْلَةِ الإِيلاَفِ |
لا ريب أنَّ مكة أدَّتْ – قبل الإسلام – دورَ الوسيط الناجح والمُحايِد بين عالمين، فموقعها الجغرافي من ناحية، وحفاظها على حياديَّتها من ناحيةٍ أخرى – حقَّق لها مكانةً عظيمة في هذا الميدان الاقتصادي، ويَكفِي دليلاً على ذلك أنَّ الإمبراطوريَّة الرومانيَّة الشرقيَّة (بيزنطة) استَعانت بتجَّار مكَّة الكِبار من القرشيِّين، كوسطاء أُمَناء للتجارة، بنقْل مُنتَجات الهند والصين إلى أسواقها.
كما تقدَّم أنَّ القرشيِّين عقَدُوا المعاهدات التجاريَّة مع أُمَراء العرب في الجزيرة العربيَّة؛ مثل: شيوخ قيس، وأقيال اليمَن، وأمراء اليمامة، وملوك غسَّان والحيرة، هذا فضلاً عن الأتاوى التي كانت تَفْرِضُها قريش على التجَّار الأجانب، وعلى العرب الَّذين لا يرتَبِطون معها بحلفٍ، من أهمِّ هذه الضَّرائب ضريبة العشور، وفي الوقْت الَّذي كان يقوم فيه تجَّار بلاد الشَّام يحملون معهم إلى مكَّة القمح والزُّيوت والخمور ومصنوعاتهم المتنوِّعة، كان لِمُتْرفِيهم مجالس للسَّمر ينصبون لها الأرائِك، ويمدُّون فيها الموائد، ويَتَفكَّهون بما طاب من ثِمارهم ويتلذَّذون بفَواكِه الطَّائف الطَّازجة أو مجفَّفات الشَّام وفلسطين المستوردة لمتاجرهم، ويعرفون طعام الفالوذج (حلوى فاخرة تُخلَط مع العسل) نقلاً عن الأمم المجاورة.
كان تجَّار الجنوب يَحمِلون معهم حاصِلات الهند: من ذهَب، وأحجار كريمة، وعاج وخشب الصندل، والتوابل، والمنسوجات الحريريَّة والقطنيَّة والكتانيَّة، والأرجوان والزعفران والأواني الفضيَّة والنُّحاسيَّة، هذا إلى جانب ما كانوا يَحمِلونه معهم من منتجات إفريقيا الشَّرقيَّة واليمن؛ كالعطور والأطياب، وخشب الأبنوس، وريش النعام، واللبان والأحجار الكريمة، والجلود.
وقد وَشَتْ هزيمة القرشيِّين في بدرٍ بأثْرِيائها المتْخمين بالثَّراء، بدَفعِهم مبالغ كبيرة فديةً لأسْراهم في بدر، وقد عُرِفَتْ أسرة بني مخزوم من الأسرات المكيَّة المشهورة بالثَّراء الفاحِش، ولعلَّ الوليد بن المغيرة (ت 1هـ/ 622م) كان أثْرى شخصيَّات هذه الأسرة.
وكان لتجَّار مكَّة في الوقت نفسه تجارةٌ رابحة مع الحبشة والصومال، تتمُّ بواسطة طريقٍ بحري، حيث كان لمكَّة ميناء على البحر الأحمر يُعرَف بميناء الشعيبة، أمَّا العملة الَّتي عرفَتْها مكَّة والحجاز عمومًا فكانت الدِينار والدِرْهم.
ولعلَّ من أهمِّ الصِّناعات التي اشتَغَل بها أهل مكَّة صناعة الأسلحة من سيوف ودروع ورماح ونبال وسكاكين، كذلك صناعة الفخار من أباريق وصحاف وقدور، فضلاً عن صناعة الأَسِرَّة والأرائك، ولصِلات أهل مكَّة التجاريَّة بالشُّعوب والقبائل والأُمَم القريبة والبعيدة، ازدادوا فهمًا بأهميَّة التجارة البينيَّة والدوليَّة مع تأثُّرهم واقتِباسهم للمَظاهِر الحضاريَّة، من اجتماعيَّة وثقافيَّة التي عرَفُوها من الرُّوم والفرس.
ثانيًا – مكَّة المكرَّمة:
2/ 1 – فضائلها ومكانتها الدينيَّة والتاريخيَّة – قصَّة بناء الكعبة المشرَّفة
لا غرْو في أنَّ مكَّة المكرَّمة كانت عند العرب قبلَ الإسلام من أبرز الأماكن الثَّقافيَّة والتِّجاريَّة، وأهم مدنهم قداسةً وعراقةً، وهي اليومَ عند المسلمين من كلِّ جنسٍ ولون، إلى جانب المدينة المنوَّرة والمسجد الأقصى المُبارَك بالقدس – ثالث المساجد في الإسلام من حيث القداسة – أعظم مدينة وأهم الديار قدسيَّة في أرجاء المعمورة كافَّة.
ونقرأ في تاريخ مكَّة المُوغِل في القِدَم أنَّ إبراهيم – عليه السلام – الذي هاجَر من “أور” في العراق في رحلةٍ طويلة ليَصِل أرضَ كنعان في فلسطين، من ثَمَّ ليُواصِل الرِّحلة إلى مكَّة المكرَّمة تُرافِقُه زوجتُه هاجر وولَدُه إسماعيل؛ حيثُ أسكنَهُما عند بيت الله الحرام أو الكعبة التي اشتَرَك مع ابنه إسماعيل في بنائها؛ ليُصبِح من يومئذٍ أوَّلَ مسجدٍ عُرِف في تاريخ البشريَّة، وهو البقعة نفسُها التي انفَجرَتْ منها عين زمزم؛ ليُحيي الله بها من جديدٍ هذه البقاع المقدَّسة ولتهوي أفئدة من الناس إليها من كلِّ المعمورة؛ استجابةً من الله – سبحانه وتعالى – لدعاء إبراهيم – عليه السلام – الذي سأل ربَّه – عزَّ وجلَّ – قائلاً:
﴿ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴾
[إبراهيم: 37]
من وحْي ما تقَدَّمَ فإنَّ بعضَ المحدِّثين والمؤرِّخِين القُدَماء يتَّفِقون على أنَّ إبراهيم – عليه السلام – قال لابنه إسماعيل: “إنَّ الله – تعالى – قد أمرَنِي أنْ أبْني له بيتًا هاهنا”، فوق الرَّبوة الحمراء القائمة قربَ بئر زمزم (بئر إسماعيل)، وطلَب من ابنِه أنْ يُعينَه في بناء البيت، فلم يزلْ إبراهيم يحفر حتَّى وصَل إلى القواعد، في ذلك يقول الله:
﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾
[البقرة: 127]
﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ ﴾
[الحج: 26]
وفي هاتَين الآيتين الكريمتَين – عند المفسِّرين – خيرُ دليلٍ على أنَّ قواعد البيت كانت مبنيَّة قبلَ إبراهيم – عليه السلام – وقد هَداه الله إليها وبُوِّئ لها؛ أي: إنَّ الأساس الأوَّل للبيت كان موجودًا، والبناء الأوَّل له كانت قواعده قائمةً بوضوحٍ على عهْد إبراهيم – عليه السلام.
كما ترى هذه المصادِرُ في الوقت نفسه أنَّ إبراهيم – عليه السلام – رفَع هذه القواعد بعد طوفان نوح – عليه السلام – وقد وقَى الله قواعد بيته وأساسه الأوَّل من هذا الطوفان المُغْرِق، يستدلُّ من هذا أيضًا أنَّ الكعبة كانت موجودةً قبل عهد نوح – عليه السلام – الأمر الَّذي يُرجِّح – كما سبق ذكره – أنَّ واضع حجر الأساس في بناء البيت العتيق آدم – عليه السلام – أو الملائكة، ومهما يكن من أمر فإنَّ إبراهيم – عليه السلام – هو رافِعُ القواعد من البيت، وعندما ارتَفَع البناء أتى إبراهيمُ – عليه السلام – بحجَرٍ ليقِف عليه أثناءَ بناء الكعبة، فسُمِّي الحجر (مقام إبراهيم) وبعد أنْ أَتَمَّ إبراهيم وابنه إسماعيل البناءَ – منذ أكثر من أربعة آلاف سنة – أمَر الله – عزَّ وجلَّ – نبيَّه إبراهيم – عليه السلام – فقال:
﴿ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴾
[الحج: 27]
، فلم يزَل منذ رفَعَه الله معمورًا.
2/2 – المرَّات التي أُعِيد فيها بناء الكعبة:
في هذا السِّياق ذكَر الأزرقي: بأنَّ الكعبة بُنِيَتْ عشر مرَّات:
- (الأولى) بناية الملائكة.
- (الثانية) بناية آدم.
- (الثَّالثة) بناية شيث ابن آدم.
- (الرَّابعة) بناية إبراهيم وإسماعيل.
- (الخامسة) بناية العمالقة.
- (السادسة) بناية جُرهُم.
- (السابعة) بناية قصي.
- (الثامنة) بناية قريش.
- (التاسعة) بناية ابن الزبير.
- (العاشرة) بناية الحجَّاج.
- ممَّا يجدر ذكرُه في هذا السِّياق أنَّ الكعبة بُنِيَتْ للمرَّة الحاديةَ عشرةَ عام (1039هـ/1629م) في عهد السلْطان العثماني مراد الرَّابع (1032 – 105هـ/1623- 1640م).
- وللمرَّة الثانية عشرة عام (1417هـ/1996م) في عهد خادم الحرَمَين الشَّريفين الملك فهد بن عبدالعزيز (1402 – 1436هـ/1982 – 2005م)؛ أي: بعد مرور حوالي 375 عامًا على بِناء السلطان العثماني مراد الرَّابع.
3/2 – مكة: المنزل والمسكن البشري الأوَّل في حِقَبٍ زمنيَّة مختلفة، وكشف بئر زمزم:
وترى هذه المصادر أيضًا أنَّ أوَّل مَن سكَن مكَّة في غابِر الأزمان هم من العَمالِقة، ثم خلَفَتْهم قبائل جُرْهُم اليمنية، وبقايا من الأمم البائدة، وفي عهد جُرْهُم قدِم إلى مكَّة – كما رأينا – إبراهيم – عليه السلام – مع زوجته هاجَر وابنهما إسماعيل الذي تَرعرَع وسطَ قبيلة جُرهم، فعرف لغتهم وتَزوَّج منهم، واحتَلَّ مكانة مَهِيبة بينهم، وبقيت لقبيلة جُرهم الزَّعامة على مكَّة والكعبة (البيت الحرام) نحوًا من ثلاثمائة سنة، حتَّى تغلَّبت عليهم قبيلة خزاعة اليمنيَّة، ثمَّ تنتزع قريش التي قوِيَت شوكَتُها – حوالي منتصف القرن الخامس الميلادي – السيادةَ من خزاعة على البيت الحرام، ليصبح زعيم قريش قصي بن كلاب الرَّئيس الديني بانتقال حجابة (سدانة) الكعبة إليه، وهو نفسه الذي بنى دار الندوة (دار الشُّورى)؛ لتكون مركزًا لاجتِماع القُرشيِّين للتَّشاوُر في شؤونِهم العامَّة.
بعد وفاة قُصَيٍّ انتقَلَت الرِّئاسة إلى ابنه عبدالدار، إلى أنْ تفرَّقت الرِّياسة في أبناء عبدمناف (شقيق قصي) فتصدَّرها هاشم بن عبدمناف، وانتهت الزعامة في قريشٍ بعد وفاة هاشِمٍ إلى ابنه عبدالمطلب المعروف باسم شيْبَة الحَمْد الذي آلَتْ إليه الرفادة (إطعام الحجاج أيَّام الموسم وسقايتهم) ظَلَّتْ سدانة الكعبة في بني عبدالمطلب يَتوارَثونها في الجاهليَّة والإسلام إلى اليوم.
ومن أبرَزِ أعمال عبدالمطلب كشْفُ بئر زمزم (بئر إسماعيل)، وإعادةُ حَفْرِه سنة (540م) بعدَ أنْ رأى في مَنامِه أنْ يحفر زمزم في المكان الذي هي فيه، وكانت زمزم طُمِسَت أيَّام جُرْهُم؛ بَيْدَ أنَّه كان لوجودها بجوار الكعبة حافِزٌ لجذب القبائل، وسكنهم حول البيت الحرام منذ زمنٍ قديم، وتتَّفِق الرِّوايات في الحديث عن معجزة زمزم، أنَّه لمَّا نفِد الماء والطعام وبدأ بكاء – ابن هاجر – إسماعيل يَتعالَى، طفقت هاجر تُهَروِل بين جبلي الصفا والمروة، حتى إذا عادَتْ تتفقَّد ولَدَها إسماعيل وجدَتْه يُصارِع الموت عطشًا، وما أنْ أتمَّت هرولتها (السعْي) سبعَ مرَّات، إذا بجبريل – عليه السلام – أمامَها يَضرِب الأرض بقدمه.
وقيل: إنَّ إسماعيل ضرَب الأرض بقدمه، فنبع الماء العذب من الأرض؛ لتظهر إلى الوجود بئر زمزم أو (بئر إسماعيل)، وهنا سَقَتْ هاجر طفلَها، لكنَّها في الوقت نفسه تملَّكها الخوف من طغيان الماء على طفلها، فأخَذَت تقول: “زمِّي يا مباركة، زمِّي”، وجعَلَت تَحُوطُه – أي: طفلها – بالتراب؛ لئلاَّ يَذهب سيلُ الماء المتدفِّق به، ويعتقد أنَّ تسمِيَة هذا البئر (العين) بزمزم جاءت من هذه الكلمات لهاجر.
قد جاء عن زمزم في الحديث الشريف: ((خَيرُ ماء عَلى وَجْهِ الأَرضِ مَاءُ زَمْزَم، فيه طَعامُ طُعمٍ وشفاءُ سُقم))، وقال – صلَّى الله عليه وسلَّم – : ((إِن شَرِبْتَ من ماءِ زَمْزم تريد الشفاء شفاك الله، وإن شربتَه لظمأٍ رواك الله، وإنْ شربته لجوعٍ أشبعك الله)).
وفي حديثٍ أنَّ الله – عزَّ وجلَّ – يَرفَع المياه العذبة قبلَ يوم القيامة وتغور المياه غير مياه زمزم، وإنها في كتاب الله – سبحانه – شراب الأبرار…
ثالثًا – مكة: المشاهد التاريخية الكبرى:
1/3 – عبدالمطلب وأبرهة الأشرم:
مِن الأحداث التاريخيَّة الكبرى في عهد عبدالمطلب محاولةُ أبرهة الأشرم أبو يكسوم حاكم اليمن من قِبَل النجاشي ملك الحبشة – هدْم الكعبة سنة (570م) أو في (571م) قاصِدًا أن يجذب الحجَّاج العرب إلى القُلَّيْسِ – كنيسة كبيرة بَناها أبرهة نفسُه بصنعاء – فحشَد لهذا الغرَض جيشًا كبيرًا تتقدَّمَه الفيلة الضخمة، اختَلَف المؤرخون في عددها؛ فمنهم مَن قال: إنَّ عددها اثنا عشر فيلاً، أو: ثلاثة عشر فيلاً، وأوصَلَها بعضهم إلى الألف فيل، على أيِّ حال وصَل أبرهة بجيشه وفيله وعسكَر على مَشارِف مكَّة، فأبى الفيل الرئيس الذي كان يَمتَطِيه أبرهة بالتقدُّم، وحاوَل الأحباش جُهدَهم مع الفيل المتقدِّم إلى الأمام، وكلَّما وجَّهوه نحوَ الكعبة تَوقَّف وبرك، وإذا وجَّهوه نحو اليمَن أسرع مُهَروِلاً باتِّجاهها، وفي اللحظة الحاسمة تدخَّلت العناية الإلهية؛ فأرسَلَ الله – سبحانه وتعالى – دِفاعًا عن بيته الكعبة المشرفة الطيرَ الأَبابيل؛ لتمني الحملةَ بهزيمةٍ نكراء مشهودة، ولتظلَّ مكة ولتَبقَى عذراء عصيبة على الغُزَاة من قُوَى الشر، وهي التي لم تَخضَع يومًا – ولن تخضع – لأيِّ مُعتَدٍ غاشم، لن يستطيع أبدًا – بإذن الله – أن يخرق أرض مكة أو يبلغ جبالها طولاً، وقد ذكَر القرآن الكريم هذا الحدث التاريخي في سورة الفيل:
﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ * أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ * وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ * تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ * فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ ﴾
[الفيل: 1 – 5].
لقد زاد هذا الحدثُ التاريخي في تقديس العرب وإجلالهم لمكة و”كعبتها المشرفة”، وأصبحت عندهم رمزًا لاستقلالهم وعزَّتهم وقوَّتهم، في الوقت نفسِه ارتَفَع شأنُ قريش وزعيمها “سيد مكة” عبدالمطلب، بعد إخفاق هذه الحملة الهالِكَة…
ومن مكرور القول: إنَّ لقاءً تَمَّ بين بعدالمطلب وأبرهة، فسأل أبرهة عبدالمطلب عن حاجته، فقال عبدالمطلب: “حاجتي أن تَرُدَّ إلى مائتي بعيرٍ أصبتَها لي”، فردَّ أبرهة: “كنتَ أعجبتَنِي حين رأيتُك، ثم زهدت فيكَ حين كلَّمتني، تكلِّمني في مائتي بعير أصبتها لك وتترك بيتًا هو دينك ودين آبائك وقد جئت لهدمه لا تكلمني فيه!”، قال: عبدالمطلب: “إني أنا ربُّ إبلي، وإنَّ للبيت ربًّا يَحمِيه”، وهكذا كان وسيكون… وخرَج عبدالمطلب من عند أبرهة غاضبًا يردِّد شعرًا:
يَا رَبِّ لاَ أَرْجُو لَهُمْ سِوَاكَا  يَا رَبِّ فَامْنَعْ مِنْهُمُ حِمَاكَا يَا رَبِّ فَامْنَعْ مِنْهُمُ حِمَاكَاإِنَّ عَدُوَّ البَيْتِ مَنْ عَادَاكَ  امْنَعْهُمُ أَنْ يُخْرِبُوا قُرَاكَ امْنَعْهُمُ أَنْ يُخْرِبُوا قُرَاكَ |
2/3 – مكة: ولادة المصطفى – صلَّى الله عليه وسلَّم – وانبلاج نور الإسلام – نور الحق والهداية:
في وسط أحداثٍ جِسام وفوضى عارِمَة، وجهالة جهلاء، وظلمات فوقها ظلمات أحاطت بجزيرة العرب من كلِّ جانب – انبَلَج نورُ الحق والهداية، بمولد سيِّد الخلق محمد بن عبدالله – صلَّى الله عليه وسلَّم – وكانت ولادته على الأرجح في الليلة الثانية عشرة من ربيع الأول الموافق للعشرين من شهر نيسان “أبريل” 570 أو 571م، ليَصُوغ للبشريَّة تاريخًا مشرقًا جديدًا، حامِلاً رسالةَ التوحيد، على غير مثالٍ سابقٍ أو لاحق، مبلِّغًا عن ربِّ العالمين الأمانةَ، ناصِحًا الأمَّة، وكان وما زال وسيبقى في عظيم خلقه، وحكمته، وشجاعته، وصدقه، وأمانته، وسموِّ أدبه، ورفيع ذوقه، ومناقبه الشريفة التي لا تُحصَى – المثلَ الأعلى، والقدوة الأسمى، والأسوة الحسنة للناس كافَّة:
| مُحَمَّدٌ أَشْرَفُ الأَعْرَابِ وَالعَجَمِ مُحَمَّدٌ خَيْرُ مَنْ يَمْشِي عَلَى قَدَمِ مُحَمَّدٌ خَيْرُ خَلْقِ اللهِ مِنْ مُضَرٍ مُحَمَّدٌ خَيْرُ رُسْلِ اللهِ كُلِّهِمِ  |
مع ظهور دعوة الحق والهداية الإلهيَّة، ارتقت مكة وتربَّعت على قمَّة المجد وذروته، وحازَتْ إلى الأبد المرتبةَ الأولى مكانةً، ولا أقدس في العالمين العربي والإسلامي، وفي كلِّ صقعٍ من أصقاع الأرض فيه مسلم، بعد أنْ أصبحت قبلة المسلمين يُولُّون وجوههم إليها خمسَ مرَّات في اليوم والليلة عند أداء كلِّ صلاة، ويشدُّون الرحال إلى حرَمِها الشريف “الكعبة المشرفة” من شتَّى أرجاء المعمورة.
وقد جعَل الله من هذه المعجزة رابطةً وعروةً وُثقَى لا انفِصام لها بين بيته الحرام بمكة والمسجد الأقصى بالقدس، عندما أَسرَى بالنبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – حيث عَرج منه إلى السموات العُلاَ، وقد خلَّد هذا الحدثَ التاريخي الخارق – الذي تَمَّ قبلَ الهجرة في السابع والعشرين من رجب – القرآنُ الكريم، في قوله – تعالى – :
﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾
[الإسراء: 1].
عن هذه المعجزة الخالدة جاء في قصيدة البُردة للبوصيري (محمد سعيد شرف الدين) (ت 695هـ/ 1295م):
| سريت من حرمٍ ليلاً إلى حــــــــــرمٍ كما سرى البدر في داجٍ من الظـلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلــــــــــةً من قاب قوسين لم تدرك ولم تــرم وأنت تخترق السبع الطباق بهــــــم في مركب كنت فيه صاحب العلــــم شرى لنا معشر الإسلام إن لنـــــــا من العناية ركناً غير منهــــــــــدم لما دعا الله داعينا لطاعتــــــــــــــه بأكرم الرسل كنا أكرم الأمــــــــــم |
وجاء عن هذه المعجزة في قصيدة “نهج البُردة” التي نظَمَها أمير الشعراء أحمد شوقي (ت 1351هـ/ 1932م) على نهج بُردة البوصيري:
| أَسرى بِكَ اللَهُ لَيلاً إذ مَلائِكُهُ وَالرُسلُ في المَسجِدِ الأَقصى عَلى قَدَمِ لَمّا خَطَرتَ بِهِ اِلتَفّوا بِسَيِّدِهِم كَالشُهبِ بِالبَدرِ أَو كَالجُندِ بِالعَلَمِ صَلّى وَراءَكَ مِنهُم كُلُّ ذي خَطَرٍ وَمَن يَفُز بِحَبيبِ اللَهِ يَأتَمِمِ حَتّى بَلَغتَ سَماءً لا يُطارُ لَها عَلى جَناحٍ وَلا يُسعى عَلى قَدَمِ وَقيلَ كُلُّ نَبِيٍّ عِندَ رُتبَتِهِ وَيا مُحَمَّدُ هَذا العَرشُ فَاِستَلِمِ |
عندما هاجَر النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – من مكَّة إلى المدينة كان يتَّجِه في صلاته – في أوَّل الأمر – إلى بيت المقدس (المسجد الأقصى) بفلسطين، وكان – عليه الصلاة والسلام – راضيًا كلَّ الرِّضا بأمر الله، بالاتِّجاه في صلاته إلى المسجد الأقصى.
على الرغم من ذلك ظلَّت الكعبة المشرفة (مكة) أحبَّ بِقاع الأرض إلى قلبه، نبض فؤاده، وهدأة وجدانه؛ لكونها البيت الأوَّل الذي أُقِيم لعباده الله، ينسَجِم هذا الشعور الفطري الصافي مع قوله – عليه الصلاة والسلام -: ((والله إنَّك لَخَيْرُ أرض الله، وأَحَبُّ أرض الله إلى الله، ولولا أنِّي أُخرِجتُ منك ما خرجت)).