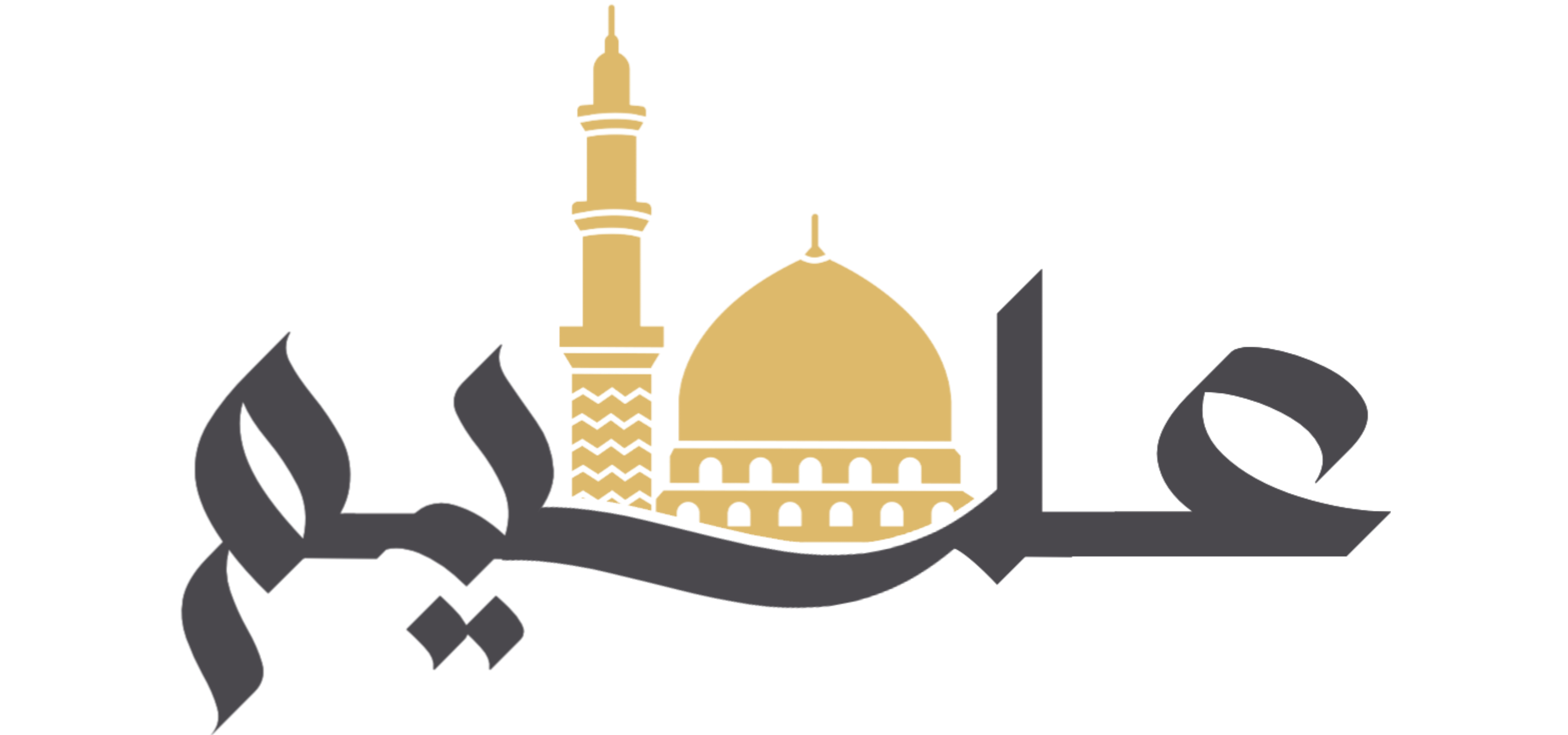كان من دأب السلف الصالح قراءة القرآن، وكأنه يتنـزل عليهم؛ فكانوا يقفون عند كل آية من آياته ويتفكرون فيها، فإن كانت آية خوف سألوا الله النجاة والعافية، وإن كانت آية رجاء حمدوا الله على ما أسبغ عليهم من نِعَم ظاهرة وباطنة، وسألوه من فضله ورحمته؛ وهكذا كان حالهم بين الرجاء في رحمة الله، والخوف من عذابه، وهذه المعادلة التي ينبغي على المسلم أن لا ينفك عنها في أحواله كافة.
وقد روي عن بعض السلف، أنه كان إذا قرأ آيات الخوف أو استمع إليها، ارتعدت مفاصله، وغشاه الخوف، وذرفت عيناه بالدموع؛ كما روي عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، أنه كان واضعاً رأسه في حِجر امرأته، فبكى فبكت امرأته، فقال: ما يبكيك ؟ قالت: رأيتك تبكي فبكيت، قال: إني ذكرت قول الله عز وجل: {وإن منكم إلا واردها} (مريم:71)، فلا أدري أأنجو منها أم لا؟
وكان أبو ميسرة إذا أوى إلى فراشه قال: يا ليت أمي لم تلدني ! ثم يبكي، فقيل له: ما يبكيك يا أبا ميسرة؟ قال: أُخبرنا أنا واردوها، ولم نُخبر أنا صادرون عنها؛ وذلك إشارة منه لقول الله تعالى: {وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا}، ومن مأثور دعائهم في هذا: اللهم أخرجني من النار سالماً، وأدخلني الجنة غانماً.
وليس الغرض هنا بيان أحوال السلف، وموقفهم من آيات الخوف، وإنما جعلنا ذلك تقدمة للحديث عن قوله تعالى: {وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا}، فقد يرى البعض أن في هذه الآية معارضة لآيات أخرى، تفيد خلاف ما تفيده هذه الآية.
إقرأ أيضا:لا إكراه في الدينوذلك أن ظاهر قوله تعالى: {وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا} يفيد أنه سبحانه سوف يُدخل النار المؤمن وغير المؤمن؛ لأن قوله تعالى: {منكم} يعم جميع الناس. لكن في الوقت نفسه، وردت آية أخرى تفيد أن المؤمنين لن يدخلوا النار، وأنه سبحانه سوف يبعدهم عنها، كما في قوله تعالى: {إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون} (الأنبياء:101). إذن، نحن أمام آيتين ظاهرهما التعارض؛ فكيف السبيل للتوفيق والجمع بينهما؟
لقد اتفق المفسرون على أن (المتقين) لا تنالهم نار جهنم بأذى، ثم هم بعد ذلك اختلفوا في بعض التفاصيل؛ فذهب أكثر المفسرين -وفي مقدمتهم الطبري- إلى أن قوله تعالى: {وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا} خطاب عام، يدخل فيه المؤمن وغير المؤمن؛ غير أن القائلين بهذا، اختلفوا في معنى (الورود) الذي جاء في الآية على أقوال ثلاثة:
القول الأول: أن المقصود من (الورود)، هو (الدخول)، أي دخول جهنم؛ والقائلون بهذا يستدلون لقولهم بالعديد من الآيات التي ورد فيها لفظ (الورود) بمعنى (الدخول)، كقوله تعالى: {يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود} (هود:98)، وقوله سبحانه: {ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا} (مريم:86)، وقوله تعالى: {إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون} (الأنبياء:98)، حيث أتى لفظ ( الورود ) فيها بمعنى (الدخول) بالاتفاق؛ ولأجل هذا استدل ابن عباس رضي الله عنهما أن (الورود) في آية مريم هو (الدخول)؛ لأن أفضل ما يفسر به القرآن هو القرآن.
إقرأ أيضا:بين الصدقة على النفس والإيثار عليهافقد ذكر الطبري فيما يرويه عن ابن عباس رضي الله عنهما، قوله: {وإن منكم إلا واردها}، قال: يدخلها. ومثل ذلك روي عن ابن مسعود ، قوله: {وإن منكم إلا واردها}، قال: داخلها.
ويشهد لهذا التفسير للآية، ما حدَّث به جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وقد اختلف في مجلسه حول معنى (الورود)، فمن قائل: لا يدخل النار مؤمن؛ ومن قائل: يدخلها المؤمن وغير المؤمن، فوضع جابر رضي الله عنه أصبعيه على أذنيه، وقال: (…صُمَّتا ! إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (الورود): الدخول؛ لا يبقي بر ولا فاجر إلا دخلها؛ فتكون على المؤمن بردًا وسلامًا، كما كانت على إبراهيم، حتى إن للنار ضجيجًا من بردهم، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثياً. رواه أحمد وغيره، قال ابن كثير: حديث غريب؛ وقال الشنقيطي: إسناده لا يقل عن درجة الحسن.
وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى: {وإن منكم إلا واردها}: قال: (يدخلونها، أو يلجونها، ثم يصدرون منها بأعمالهم)، رواه أحمد.
والذي يقوي القول بأن المراد بـ (الورود) هو (الدخول)، قوله تعالى في الآية التالية للآية موضع الحديث: {ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا} (مريم:72).
وقد أجاب القائلون: إن (الورود) هو (الدخول) على قوله تعالى: {أولئك عنها مبعدون}، بأنهم مبعدون عن عذابها وألمها، فلا ينافي ذلك ورودهم إياها، من غير شعورهم بألم ولا حر منها، كما حدث مع إبراهيم الخليل عليه السلام؛ واستدلوا لهذا بحديث جابر رضي الله عنه المتقدم.
إقرأ أيضا:خصوص الذنب وعموم العقابالقول الثاني: أن المراد بـ (الورود) هو (المرور) على الصراط المضروب المقام فوق جهنم؛ ودليل من قال بهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: (…ويضرب جسر جهنم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يجيز، ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلِّم سلِّم، وبه كلاليب مثل شوك السعدان، غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله، فتخطف الناس بأعمالهم) متفق عليه؛ وأيضًا ما جاء عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، وفيه: (…وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك، تأخذ من شاء الله، ثم يطفأ نور المنافقين، ثم ينجو المؤمنون…).
وفي رواية ثانية لـ مسلم، جاء فيها: (…فيأتون محمدًا صلى الله عليه وسلم، فيقوم فيؤْذن له، وترسل الأمانة والرحم، فتقومان جنبتي الصراط يمينًا وشمالاً، فيمر أولكم كالبرق ، قال: قلت: بأبي أنت وأمي! أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر، ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط، يقول: رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل، فلا يستطيع السير إلا زحفًا، قال: وفي حافتي الصراط كلاليب، معلقة مأمورة بأخذ من أُمرت به …)؛ فهذه الأحاديث وما في معناها، تدل على أن المراد بـ (الورود) هو (المرور) وليس (الدخول).
وذكر الشيخ الشنقيطي في تفسيره، أنه قد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه، والحسن البصري، وقتادة، أنهم فسروا (الورود) في الآية بـ (المرور).
القول الثالث: أن المراد بـ (الورود) هو (المشارفة) و(المقاربة) وليس (الدخول) ولا (المرور)، ودليل من فسر الآية بهذا بعض آيات ورد فيها لفظ (الورود) بمعنى (المشارفة) و(المقاربة)، كقوله تعالى: {وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم} (يوسف:19)، وقوله سبحانه: {ولما ورد ماء مدين} (القصص:23)، قالوا: (ورود) الماء لا يلزم منه الدخول فيه؛ لأن (الورود) في الآيتين، لو كان يعني (الدخول) فيه، لكان معناهما غير مستقيم، فتعين أن يكون المقصود بـ (الورود) فيهما (ورود) مقاربة ومشارفة؛ والذي يؤيد أن (الورود) بمعنى (المشارفة) و(المقاربة) قولك: وردت الماء إذا جئته، وليس يلزم أن تدخل فيه. ومن هذا القبيل قول زهير بن أبي سلمة:
فلما وردن الماء زرقا جمامه وضعن عصي الحاضر المتخيم
قالوا: والعرب تقول: وردت القافلة البلد، وإن لم تدخله، ولكن قربت منه.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الخطاب في الآية خاص بالكافرين ولا يشمل المؤمنين؛ ودليل من قال بهذا، أن السياق الذي وردت فيه الآية وارد في أهل النار، والحديث عنهم دون غيرهم، وإذا كان الأمر كذلك، كان الأنسب -بحسب رأي هذا الفريق- حمل الآية على الكافرين دون المؤمنين؛ لأن حمل الآية على أنها خطاب للمؤمنين والكافرين في آن معًا -كما يقول ابن عاشور- “معنى ثقيل ينبو عنه السياق، إذ لا مناسبة بينه وبين سياق الآيات السابقة؛ ولأن فضل الله على المؤمنين بالجنة وتشريفهم بالمنازل الرفيعة، ينافي أن يسوقهم مع المشركين مساقًا واحدًا”؛ لكن، يجاب على من استدل بالسياق، بالسياق نفسه، حيث جاء فيه ما يفيد نجاة المؤمنين من هذا (الورود)، وذلك في قوله تعالى: {ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا}.
وقد تقدم أن الذي عليه أكثر أهل التفسير، أن الآية عامة في المؤمنين وغير المؤمنين، لكن الخلاف وقع بينهم في تفسير هذا (الورود) هل هو دخول إلى النار، أم هو مرور على جسر منصوب عليها، أم هو اقتراب منها؛ وكل هذه المعاني يحتملها معنى (الورود)، وعلى ضوئها يمكن فهم الآيتين الكريمتين والجمع بينهما، ويزول ما يبدو بينهما من تعارض.