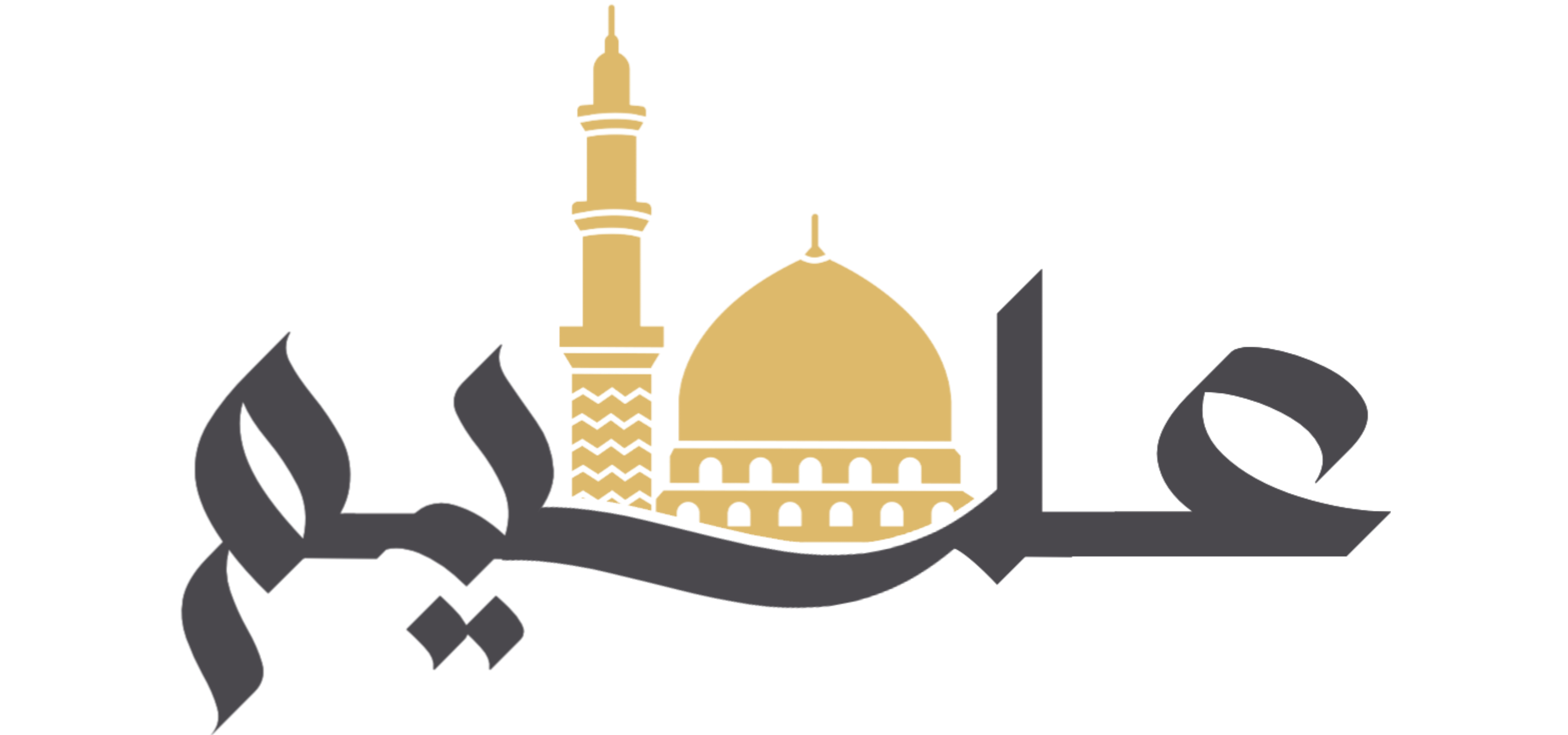نسب الرسول – صلى الله عليه وسلم -:
الرسول هو «محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبدمناف»، يتصل نسبه بإسماعيل بن إبراهيم – عليهما السلام -.
وكان جده «عبد المطلب» قد نذر وهو يعيد حفر بئر «زمزم» – بناءً على رؤية رآها – أنه إن رزقه الله بعشرة من الأولاد ليذبحن أحدهم قربانًا للآلهة، فلما تحقَّق له ذلك أراد أن يفى بنذره، فضرب الأقداح عند «الكعبة» كما كانت عادتهم على أولاده جميعًا، ومن يخرج عليه السهم يكن هو الذى ارتضته الآلهة قربانًا لها، فخرج السهم على «عبد الله» فعزم «عبد المطلب» على ذبح ابنه.
ولما ذاع خبر «عبد المطلب» مع ابنه فى «مكة» فزع أهلها من هذا الحدث، وذهبوا إليه يثنونه عن أمره، فلمَّا لم يجدوا منه استجابة لرجائهم، اقترحوا عليه الذهاب إلى عرَّافة مشهورة؛ لعلهم يجدون عندها لهذه المشكلة حلاً، فوافقهم على ذلك.
فلما ذهبوا إلى العرَّافة وقصُّوا عليها ماحدث، اقترحت عليهم أن يضربوا القداح عند آلهتهم، على «عبد الله» وعلى عشرة من الإبل، فإن خرجت على «عبد الله» زادوا عشرة من الإبل، حتى ترضى الآلهة وتخرج القداح على الإبل، ففعل ذلك «عبد المطلب»، حتى وصل العدد إلى مائة، وعندئذٍ خرج السهم مشيرًا إلى الإبل، ففرح «عبد المطلب»، وفرحت معه «مكة»، ونحر الإبل، وأطعم الناس ابتهاجًا بنجاة ابنه الحبيب من الذبح.
إقرأ أيضا:خلافة علي بن ابى طالبزواج عبد الله من آمنة بنت وهب:
بعد نجاة «عبد الله بن عبد المطلب» من الذبح زوَّجه من «آمنة ابنة وهب بن عبد مناف بن زُهرة».
وبعد أيام من العرس خرج عبد الله فى رحلة تجارية إلى «الشام»، فخرج مع قافلة قرشية وباع واشترى، وفى عودته مر بيثرب؛ ليزور أخوال أبيه من «بنى النجار»، لكنه مرض فى أثناء زيارته، فلما بلغ «عبد المطلب» خبر مرض ابنه، أرسل على الفور أكبر أبنائه «الحارث بن عبد المطلب» إلى «يثرب» ليعود بأخيه، لكن «عبد الله» تُوفِّى قبلأن يصل أخوه إلى «يثرب»، فحزن «عبدالمطلب» حزنًا شديدًا على موت ابنه «عبدالله» الذى لم يتجاوز الخامسة والعشرين من عمره، ولم يمضِ على زواجه سوى شهور قليلة.
ولما خفَّت موجة الحزن على آمنة، بدأت تحس بجنين يتحرك فى أحشائها، فتعلَّق به أملُها، عسى أن يعوضها فقد زوجها الحبيب، وأخبرت «عبدالمطلب» بحملها، ففرح لذلك فرحًا شديدًا، وامتلأ قلبه أملاً ورجاءً فى أن يأتى هذا الحمل بولد يعوضه عن ابنه الفقيد.
حادثة الفيل:
بعد أن حكم «أبرهة» «اليمن» تملكته الغيرة من الكعبة المشرفة، وأراد أن يصرف العرب عن زيارتها، فبنى كنيسة ضخمة بالغة الروعة، تُسمَّى «القُلَّيس»، وساق أهل «اليمن» إلى التوجه إليها والتعبد فيها، لكنه لم يفلح فى ذلك، وزاد من غضبه أن أحد الأعراب عبث بالكنيسة وقذَّرها، فأقسم «أبرهة» ليهدمن الكعبة، ويطأن «مكة»، وجهَّز لذلك جيشًا جرارًا، تصاحبه الفيلة، وفى مقدمتها فيل عظيم، ذو شهرة خاصة عندهم.
إقرأ أيضا:العالم قبل الإسلاموحينما علمت العرب بنية «أبرهة» تصدَّوا له، لكنهم لم يفلحوا فى وقف زحفه، حتى إذا بلغ جيش «أبرهة» «المغمَّس» – وهو مكان بين «الطائف» و «مكة» – ساق إليه أموال «تهامة» من «قريش» وغيرها، وكان فيها مائتا بعير لعبد المطلب بن هاشم، فهمَّت «قريش» وقبائل العرب بقتال «أبرهة»، ولكنهم وجدوا أنفسهم لا طاقة لهم بحربه، فتفرقوا عنه دون قتال.
أرسل «أبرهة» إلى «عبدالمطلب» يُبلغِه أنه لم يأتِ لحربهم، وإنما جاء لهدم البيت، فإن تركوه وما أراد فلا حاجة له فى دمائهم، فذهب «عبدالمطلب» إليه، فلما دخل نزل «أبرهة» من سريره، وجلس على البساط، وأجلس «عبدالمطلب» إلى جانبه، وأكرمه وأجلَّه، فطلب «عبدالمطلب» منه أن يرد عليه إبله التى أخذوها، فقال «أبرهة»:
أعجبتنى حين رأيتك، وزهدتُ فيك حين كلمتنى، تترك بيتًا هو دينك ودين آبائك، جئتُ لأهدمه، وتكلمنى فى مائتى بعير أصبتها لك؟فقال: «عبد المطلب»: إنى رب الإبل (أى صاحبها) وإن للبيت ربًا سيحميه. قال «أبرهة»: ما كان ليمتنع منى، فرد عليه «عبد المطلب»:
أنت وذاك، ثم رد «أبرهة» الإبل لعبد المطلب.
أمر «عبد المطلب» قريشًا بالخروج من «مكة»، والاحتماء فى شعاب الجبال، وتوجه هو إلى باب «الكعبة»، وتعلَّق به مع نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه، وانطلق جيش «أبرهة» نحو «مكة»، وحينما اقترب منها برك الفيل الأكبر الذى يتقدم الجيش رافضًا الدخول، وتعبوا فى إجباره على اقتحام «مكة»، وكانوا عندما يوجهونه إلى جهة غير «مكة» ينهض ويهرول.
إقرأ أيضا:خلافة ابو بكر الصديقثم شاء الله أن يهلك «أبرهة» وجيشه، فأرسل عليهم جماعات من الطير، أخذت ترميهم بحجارة، فقضت عليهم جميعًا، وتساقطوا كأوراق الشجر الجافة الممزَّقة، كما حكى ذلك القرآن الكريم: [ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم فى تضليل وأرسل عليهم طيرًا أبابيل ترميهم بحجارةٍ من سجيل فجعلهم كعصف مأكول]. [سورة الفيل].
مولد النبى – صلى الله عليه وسلم -:
وفى يوم الاثنين الموافق (12 من شهر ربيع الأول سنة 570م) (عام الفيل) ولدت «آمنة» وليدها، يتلألأ النور من وجهه الكريم، أكحل أدعج مختونًا، يرنو ببصره إلى الأفق، ويشير بسبابته إلى السماء، فهرولت قابلته، وهى «أم عبد الرحمن بن عوف» إلى جده «عبد المطلب» تزف إليه البشرى، وتنقل إليه ذلك الخبر السعيد، فكاد الرجل الوقور يطير من الفرحة، وفرح الهاشميون جميعًا، حتى إن عمه «أبالهب» أعتق الجارية «ثويبة» التى أبلغته الخبر، وكانت أول من أرضعت خير البشر.
سمَّى «عبد المطلب» حفيده «محمدًا»، وهو اسم لم يكن مألوفًا أو منتشرًا فى بلاد العرب، ولما سُئل عن ذلك، قال: رجوت أن يكون محمودًا فى الأرض وفى السماء.
طفولته وصباه:
فى اليوم السابع لميلاد النبى – صلى الله عليه وسلم – أمر جده بجزور فنحرت، وأقام حفلا دعا إليه كبار رجالات «قريش» احتفاءً بهذاالوليد الكريم، وانتظرت «آمنة» المرضعات اللائى كن يأتين من البادية إلى «مكة»، ليأخذن الأطفال إلى ديارهن لإرضاعهم بأجر، وكانت عادة أشراف «مكة» ألا ترضع الأم أطفالها، مفضلين أن تكون المرضعة من البادية؛ لتأخذ الطفل معها، حيث يعيش فى جو ملائم لنموه، من سماء صافية، وشمس مشرقة، وهواء نقى، وكانت هناك قبائل مشهورة بهذا العمل مثل «بنى سعد».
وكان محمد من نصيب واحدة منهن تُدعَى «حليمة السعدية» لم تكن تدرى حين أخذته أنها أسعد المرضعات جميعًا، فقد حلَّت عليها الخيرات، وتوالت عليها البركات، بفضل هذا الطفل الرضيع، فسمنت أغنامها العجاف، وزادت ألبانها وبارك الله لها فى كل ما عندها.
مكث «محمد» عند «حليمة» عامين، وهو موضع عطفها ورعايتها، ثم عادت به إلى أمه، وألحت عليها أن تدعه يعود معها، ليبقى مدة أخرى، فوافقت «آمنة» وعادت به «حليمة» إلى خيام أهلها.
حادث شق الصدر:
بقى «محمد» عند «حليمة السعدية» بعد عودتها ثلاثة أعوام أخرى، حدثت له فى آخرها حادثةُ شقِّ الصدر، وملخصها كما ترويها أوثق مصادر السيرة: أن «محمدًا» كان يلعب أو يرعى الغنم مع أترابه من الأطفال، خلف مساكن «بنى سعد» فجاءه رجلان عليهما ثياب بيض، فأخذاه فأضجعاه على الأرض، وشقا صدره وغسلاه، وأخرجا منه شيئًا، ثم أعاداه كما كان.
ولما رأى الأطفال ما حدث، ذهب واحد منهم إلى «حليمة» فأخبرها بما رأى، فخرجت فزعة هى وزوجها «أبو كبشة» فوجدا «محمدًا» ممتقعًا لونه، فسألته «حليمة» عما حدث فأخبرها، فخشيت أن يكون ما حدث له مسٌ من الجن، وتخوفت عاقبة ذلك على الطفل، فأعادته إلى أمه، وقصت عليها ماحدث لطفلها.
موت آمنة بنت وهب:
لما بلغ «محمد» السادسة من عمره أخذته أمه فى رحلة إلى «يثرب»؛ ليزور معها قبر أبيه، ويرى أخوال جده «عبد المطلب» من «بنى النجار».
وفى طريق العودة مرضت «آمنة» واشتدَّ عليها المرض، وتُوفيت فىمكان يُسمى «الأبواء» بين «مكة» و «المدينة». وهكذا شاءت إرادة الله أن يفقد «محمد» أمه، وهو فى هذه السن الصغيرة، وهو أشد ما يكون احتياجًا إليها، فتضاعف عليه اليتم، ولكن للهِ فى خلقهِ حِكم لا يعلمها إلا هو تعالى، فإن كان «محمدٌ» قد حُرِمَ من أبويه.
فإن الله هو الذى سيتولى رعايته وتعليمه.
ضم «عبد المطلب» حفيده «محمدًا» إلى كفالته؛ لأن ابنه «عبد الله» لم يترك ثروة كبيرة، وكل ما تركه كان خمسة من الإبل، وبعضًا من الأغنام، و «أم أيمن» (بركة) التى أصبحت حاضنة «محمد» وراعيته بعد فقد أمه، وقد عوضته كثيرًا عن حنان الأم.
لكن كفالة «عبد المطلب» لمحمد لم تدم طويلا، إذ استمرت عامين بعد وفاة «آمنة»، كان خلالهما نعم الأب الحنون، فحزن «محمد» على فقده حزنًا شديدًا، وبكاه بكاءً مرا وهو يودعه إلى مثواه الأخير.
وبعد وفاة «عبد المطلب» انتقل «محمد» إلى كفالة عمه «أبى طالب»، ومع أنه لم يكن أكثر أعمامه مالا وأوسعهم ثراءً، بل كان أكثرهم أولادًا وأثقلهم مؤونة؛ فإنه كان شديد العطف عليه، والرعاية له، فضمه إلى عياله، وكان يفضله عليهم فى كل شىء.
اشتغاله برعى الغنم:
لم يرض «محمدٌ» أن يكون عالة على عمّه، وبخاصة أنه يرى ضيق ذات يده، فأراد أن يعمل ليعول نفسه، ويكسب قوته، ويساعد عمه إن أمكن ذلك، فاشتغل برعى الأغنام، وهو عمل يناسب سنه، وهذه كانت حرفة الأنبياء من قبله، لقول النبى – صلى الله عليه وسلم -: «ما من نبى إلا ورعى الغنم»، قيل: وأنت يا رسول الله؟ قال: «وأنا».
رحلته الأولى إلى الشام:
وجد «محمد» فى عمه «أبى طالب» عطفًا وحنانًا عوَّضه عن فقد جدِّه، فكان يؤثره على أولاده، ولا يكاد يردُّ له طلبًا، فلما رغب «محمد» فى أن يصحب عمه فى رحلة إلى «الشام»، أجابه إلى ذلك، رغم أنه كان يخشى عليه من طول الطريق، ومشقة السفر، وهو لم يزل غلامًا صغيرًا لم يتجاوز الثانية عشرة من عمره.
انطلق «محمد» مع عمه فى تلك الرحلة إلى «الشام»، وهناك حدثت له قصة عجيبة لفتت أنظار القافلة كلها، لكنهم لم يستطيعوا لها تفسيرًا، وذلك أن راهبًا نصرانيا، يدعى «بحيرا» كان يتعبَّد فى صومعته فى بادية «الشام»، على طريق القوافل، ولم يكن يحفل بأحدٍ يمرُّ عليه، لكنه فى هذه المرة نزل من صومعته لما رأى القافلة القرشية وذهب إليهم، ودعاهم إلى طعام، وطلب منهم أن يحضروا جميعًا ولا يتركوا أحدًا يتخلف.
ولما حضر «محمد» مع القوم سأل الراهبُ «أبا طالب»: من يكون منك هذا الغلام؟ فقال: ابنى، فقال له: ما ينبغى لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا، فقال: ابن أخى، قال: صدقت. ثم رأى خاتم النبوة على كتف النبى – صلى الله عليه وسلم -، وقال لأبى طالب: ارجع بابن أخيك هذا فسوف يكون له شأن عظيم، واحذر عليه اليهود، فلو عرفوا منه الذى أعرف ليمسنه منهم شر.
وقعت كلمات الراهب من «أبى طالب» موقعًا جميلا، فشكر الراهب على هذه النصيحة الغالية التى لا تصدر إلا عن رجلٍ صالح، وعاد بابن أخيه إلى «مكة».
رحلته الثانية إلى الشام فى تجارة خديجة:
ذهب «محمد» هذه المرة إلى «الشام» فى مهمة تجارية، لا للتنزه أو الزيارة كما كان فى الأولى، ذلك أن «أبا طالب» رأى ابن أخيه قد بلغ مرحلة الشباب، ولابد له من أن يتزوَّج ويعول أسرة، ولكن من أين لمحمد بالمال؟ فقال لابن أخيه بعد أن أحسن له التدبير: «يا ابن أخى أنا رجل لا مال لى، وقد اشتدَّ الزمانُ علينا، وقد بلغنى أن خديجة بنت خويلد استأجرت فلانًا ببكرين (أى جملين صغيرين) ولسنا نرضى لك بمثل ما أعطته فهل لك أن أكلمها؟» قال «محمد»: «ما أحببتَ ياعمى».
ويكشف هذا الحوار القصير الظروف المالية الصعبة التى كان يمر بها «أبو طالب»، لكن ذلك لم يجعله يضيق بابن أخيه، وإنما خاطبه فى رفق وشاوره قبل أن يفاتحه فى أمر عمله مع «خديجة»، وفى الوقت نفسه نلمس أن «محمدًا» – صلى الله عليه وسلم – كان يشعر بمايعانيه عمه، فلم يملك إلا أن يقول له: «ما أحببتَ يا عمى».
توجه «أبو طالب» إلى «خديجة» وقال لها: «هل لك يا «خديجة» أن تستأجرى «محمدًا»؟ فقد بلغنا أنك استأجرت فلانًا ببكرين، ولسنا نرضى لمحمد دون أربعة». فأجابت «خديجة» بلهجة تحمل الوداد والاحترام للشيخ الوقور: «لو سألت ذلك لبعيد بغيض فعلنا، فكيف وقد سألتَه لقريب حبيب» (1).
خرج «محمد» فى تجارة «خديجة» يصحبه غلامها «ميسرة» وكان صاحب خبرة فى التجارة ومعرفة بأصولها، أثيرًا لديها، تأتمنه على مالها وتجارتها، وكانت هذه الرحلة ناجحة وموفقة كل التوفيق، وربحت أكثر من أية مرة سابقة.
وفى طريق العودة اقترح «ميسرة» على «محمد» أن يسبقه إلى «مكة»؛ ليكون أول من يبشر «خديجة» بعودتهما سالمين وبنجاح تجارتها، وعندما بلغ «خديجة» الأمر سُرَّت أيما سرور، وأعجبت بما قصَّه «ميسرة» على سمعها من شأن «محمد»، من أمانة، ورقة شمائل، وسمو خلق، وازدادت إعجابًا لما سمعت «محمدًا»، وما لبث هذا الإعجاب أن تحول إلى تقدير ورغبة فى الزواج.
مشاركة محمد فى الحياة العامة:
شارك «محمد» – صلى الله عليه وسلم – قومه فى حياتهم العامة قبل البعثة، فاشترك فى «حرب الفِجَار»، وهو فى نحو الخامسة عشرة من عمره، وهى حرب وقعت أحداثها فى الأشهر الحرم، ولذا سميت بحرب الفجار، وسببها أن «النعمان بن المنذر» أمير «الحيرة» اعتاد أن يرسل كل موسم قافلة تجارية إلى سوق «عكاظ» بالقرب من «مكة» المكرمة، وكان يستأجرُ لها حراسًا من القبائل القريبة من «مكة»، فعرض رجلان أنفسهما لهذه المهمة، أحدهما من «هوازن» يسمى «عُروة»، والآخر من «كنانة» يسمى «البَرَّاض»، فاختار «النعمان» «عروة»، فقتله «البراض»، فوقع القتال بين قبيلتيهما لهذا السبب، واستمر أربع سنوات وانتهى بالصلح بين المتحاربين، وقد وصف النبى – صلى الله عليه وسلم – مشاركته فى هذه الحرب بقوله: «كنت أنبل على أعمامى» أى يرد إليهم نبل عدوهم إذا رموهم بها.
حلف الفضول:
وكما شارك «محمد» قومه فى الحرب فقد شاركهم فى السلم؛ حيث شهد «حلف الفضول»، الذى تكوَّن عقب حرب الفجار، وكان أول من دعا إليه عمه «الزبير بن عبد المطلب»؛ لنصرة المظلوم أيا كان، من أهل «مكة» أو من غيرهم، واجتمعت بعض بطون «قريش»: «بنو هاشم» و «بنو زهرة»، و «بنو أسد»، و «بنو تيم» فى دار «عبد الله بن جدعان»، وتعاهدوا ليكونن مع المظلوم حتى يُردَّ إليه حقه.
ويصف النبى مشاركته فى هذا الحلف بقوله: «لقد شهدت مع عمومتى حلفًا فى دار «عبد الله بن جدعان» ما أحب أن لى به حمر النعم، ولو أدعى به فى الإسلام لأجبت». بناء الكعبة:
نزل سيل على «الكعبة» قبل بعثة النبى بحوالى خمسة أعوام، هدَّم جدرانها، فعزمت «قريش» على إعادة بنائها، وقسَّمت العمل بين بطونها، وكان النبى – صلى الله عليه وسلم – يعمل بنفسه معهم، ويحمل الحجارة، حتى إذا ارتفع البناء نحو قامة الرجل اختلفوا فيمن يضع «الحجر الأسود» فىمكانه؛ كل قبيلة تريد أن تحوز هذا الشرف دون غيرها، واشتد الخلاف بينهم حتى تداعوا إلى الحرب، ففزع «أبو أمية بن المغيرة» وخشى عاقبة ذلك، فأشار عليهم بأن يحتكموا إلى أول رجل يدخل عليهم، فوافقوا على ذلك.
كان النبى – صلى الله عليه وسلم – أول داخل عليهم، فاستبشروا خيرًا، وقالوا: هذا الأمين رضينا به حكمًا، فطلب منهم أن يبسطوا ثوبًا، ثم وضع الحجر فيه، وطلب من زعماء القبائل أن يمسك كل منهم بطرف، ليتمكَّنوا من رفع الحجر إلى موضعه، ثم أخذه النبى – صلى الله عليه وسلم – بيده الشريفة، ووضعه فى مكانه.
زواج محمد من خديجة:
كانت «خديجة بنت خويلد الأسدية» امرأة شريفة، ذات حسب وجمال ومال تزوجت مرتين من قبل، وعزمت بعد موت زوجها الثانى ألاتتزوج مرة أخرى، وأن تتفرغ لإدارة ثروتها، وتنمية تجارتها.
ولكنها حين اتصلت بمحمد – صلى الله عليه وسلم – وعمل فى تجارتها، ورأت فيه من خصال الخير أعجبت به ورغبت فى الزواج منه، وأسرَّت بذلك إلى إحدىصديقاتها المقرَّبات، فذهبت إلى «محمد» وسألته ما يمنعك أن تتزوج؟ قال ما بيدى ما أتزوج به. قالت فإن كُفِيتَ ذلك ودُعيت إلى الجمال والمال والشرف والكفاءة، ألا تجيب؟ قال فمن هى؟ قالت خديجة، فقال كيف لى بذلك؟ قالت علىَّ ذلك، فوافق علىالفور، وعادت «نفيسة» إلى «خديجة»، تزفُّ إليها تلك البشرى فسُرَّت سرورًا عظيمًا.
وذهب «محمد» مع أعمامه إلى بيت «خديجة» لإعلان الخطبة، وألقى «أبو طالب» خطبة قصيرة أثنى فيها على ابن أخيه، وأنه لا يعدله شاب فى «قريش»، فى خلقه وصدقه وأمانته، وإن كان قليل المال، فالمال عرض زائل، ثم وجَّه كلامه إلى أهل «خديجة» فقال: «إن محمدًا له فى «خديجة» رغبة، ولها فيه مثل ذلك»، فوافقوا على الخطبة، وأقاموا وليمة بهذه المناسبة السعيدة، وقدَّم «محمد» لخديجة صداقًا قدره عشرون بكرة، ثم تم الزواج، وانتقل «محمد» إلى بيت «خديجة» حيث عاش معها.
وهكذا شاءت الأقدار لهذه السيدة الكريمة أن تقترن بسيد الخلق أجمعين، وأن تصبح أول أُم للمؤمنين، وأن تكون خير عون له، فكانت أول من آمن به وكانت تواسيه بمالها، كما كانت حياته معها التى دامت نحو خمسة وعشرين عامًا تملؤها السعادة، ورزقه الله منها بستة أولاد؛ اثنين من الذكور هما: «القاسم» و «عبد الله»، وقد ماتا قبل البعثة، وأربع بنات، هن: «زينب» وقد تزوجها ابن خالتها «أبو العاص بن الربيع»، و «رقية» و «أم كلثوم» وقد تزوجهما «عثمان بن عفان»، واحدة بعد الأخرى، و «فاطمة» وتزوجت بعلى بن أبى طالب.
من الزواج إلى البعثة:
كان عمر النبى – صلى الله عليه وسلم – حين تزوج السيدة «خديجة» خمسًا وعشرين سنة، وكان عمره حين بعثه الله بالرسالة على رأس الأربعين، فماذا كان يعمل فى المدة التى بين الزواج والبعثة؟ إن مصادر السيرة النبوية لم تمدنا بمعلومات كثيرة عن هذه الفترة من حياته، سوى أنه كان دائم التأمل فى الكون الفسيح، والتفكير فىالقوة التى أبدعته وأحكمت صنعه، وأنه رفض ما عليه قومه من عبادة الأصنام، وما غرقوا فيه من الفساد والمجون، فلم يسجد لصنم، ولم يحضر مجلس لهو وعبث، بل كان يعتكف شهرًا من كل سنة فى غار «حراء»، يتعبد فيه، ويجد فيه فرصة مناسبة للتفكر والتأمل، بعيدًا عن صخب «مكة» وضجيجها. وكان شهره المفضل الذى يقضيه فى الغار هو شهر رمضان المبارك.
ويبدو أنه فى تأمله هذا كان ينشد مخرجًا للعالم مما هو فيه من شرك ووثنية؛ لأن ما بقى من الشرائع القديمة لم يكن كافيًا ليريح نفسه المتشوقة إلى الحق المجرد والحقيقة المطلقة، وظل كذلك حتى أتاه «جبريل» – عليه السلام- بالوحى.