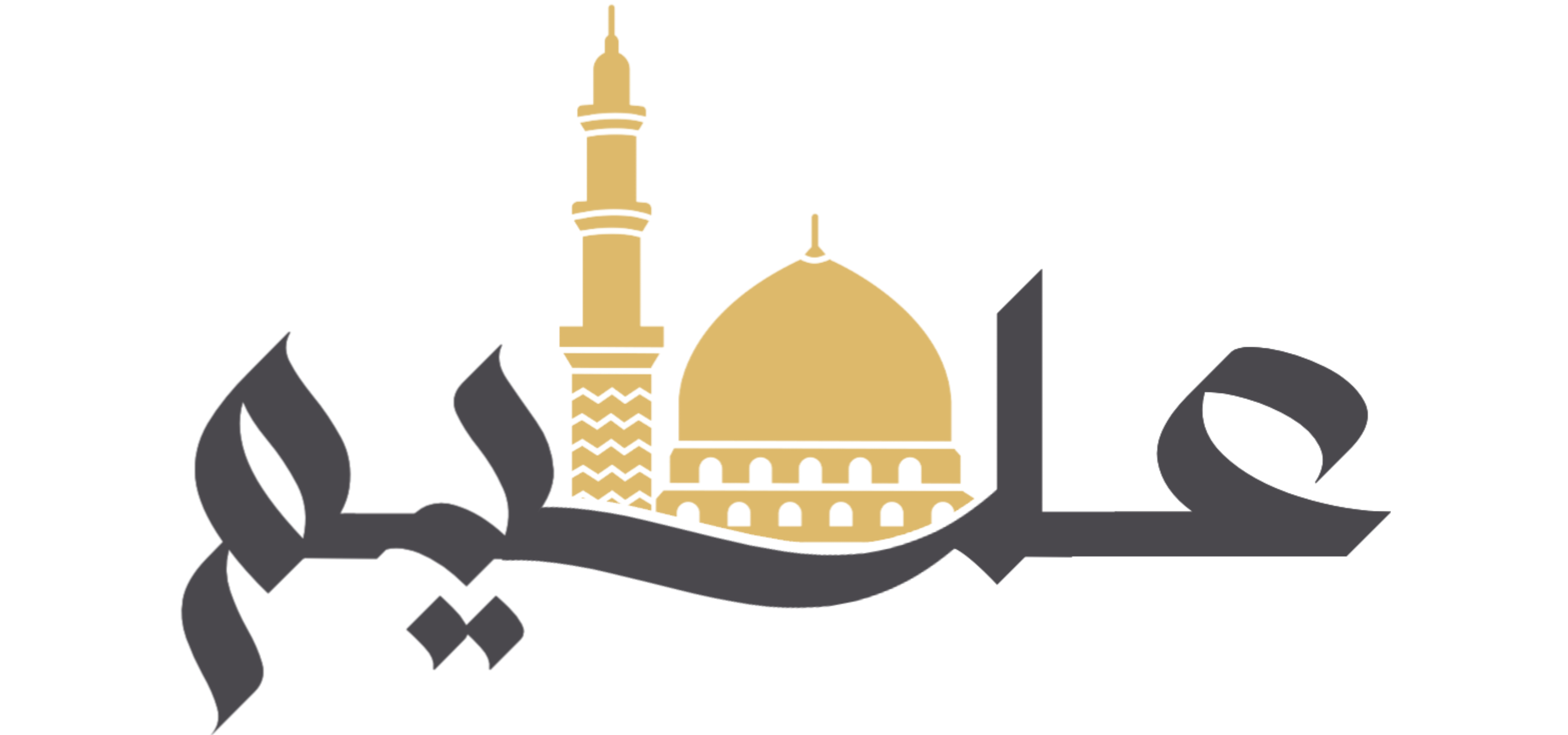بناء الدولة الإسلامية:
أصبحت «المدينة» منذ أن وصل النبى – صلى الله عليه وسلم – إليها منزل الوحى، ومعقل الإسلام، ومركز إشعاعه الذى أضاء العالم، وشرع النبى فور وصوله فى بناء مسجده الذى شارك فى بنائه بنفسه مع أصحابه، وكان بناؤه متواضعًا؛ حيث بُنى من الطين أو الطوب اللبن، وكان سقفه من جريد النخل، وأعمدته من جذوعه، وفرشه الحصى، كما كان مربع الشكل، طول ضلعه نحو مائة ذراع.
وهذا المسجد المتواضع البناء كان ذا شأن عظيم فى تاريخ الإسلام، فلم تقتصر وظيفته على أداء الصلوات فيه، بل كان مدرسة تخرَّج فيها الرعيل الأول من المسلمين، حملة لواء الإسلام ودعاته، مكانًا تُعقد فيه الجلسات لمناقشة الأمور العامة التى تتصل بحياة المسلمين ودينهم ودولتهم. وفيه استقبل الرسول – صلى الله عليه وسلم – وفود القبائل وسفراء الملوك والأمراء.
الإخاء بين المهاجرين والأنصار:
وهو الأساس الثانى الذى أقام الرسول – صلى الله عليه وسلم – عليه دولته، ذلك أن «المدينة» فتحت صدرها الرحيب للمهاجرين، واستقبلهم الأنصار بحفاوة لا نظير لها فى التاريخ، فما نزل مهاجر على أنصارى إلا بقرعة، لتنافس الأنصار وتزاحمهم على استضافة المهاجرين، فآخى الرسول – صلى الله عليه وسلم – بين الفريقين إخاءً ربط بين قلوبهم جميعًا، فأصبحت عروة الإيمان فوق كل أسباب الصلات البشرية، وأصبح النسب الإسلامى مقدمًا على سائر الأنساب.
إقرأ أيضا:خلافة علي بن ابى طالبمعاهدة المدينة:
كانت الوثيقة الخالدة التى كتبها الرسول – صلى الله عليه وسلم – مع اليهود الأساس الثالث لدولة الرسول فى «المدينة»، فبعد أن اطمأن على قوة جبهة المسلمين وسلامتهم، التفت إلى «المدينة»، فوضع لها نظامًا عامًا ثابتًا يحدد العلاقات والحقوق والواجبات بين سكانها جميعًا؛ مسلمين وغير مسلمين، فاليهود يقيمون فى «المدينة» منذ زمن طويل، وكانوا من قبل يقتسمون الزعامة مع الأوس والخزرج،وهؤلاء آمنوا بالله ورسوله، على حين بقى اليهود على دينهم ولم يؤمنوا، ولم يجبرهم الرسول على اعتناق الإسلام؛ إذ لا إكراه فى الدين، ومن ثم كان لابد من تحديد وضعهم فى الدولة الجديدة بنصوص صريحة، يُرجع إليها عند الضرورة.
ونص المعاهدة، كما رواها «ابن إسحاق»:
«بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب من محمد النبى – صلى الله عليه وسلم – بين المؤمنين والمسلمين، من قريش ويثرب، ومن تبعهم فلحق بهم، وجاهد معهم، أنهم أمة واحدة من دون الناس» وهذا إعلان صريح للأساس العقدى للدولة الجديدة، وباب الانتساب إليها هوالإيمان بالله ورسوله، وعلى هذا الأساس تمارس الدولة سياستها وسلطتها العليا فى الداخل والخارج. وجاء فى المعاهدة؛ وهو فى غاية الأهمية:
«وأنه من تبعنا من يهود، فإن له النصر والأسوة غير مظلومين، ولا متناصر عليهم، وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين، ماداموا محاربين، وأن يهود بنى عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم، .. وأن ليهود بنى الحارث مثل ما ليهود بنى عوف، .. ».
إقرأ أيضا:خلافة علي بن ابى طالبوأخذت الوثيقة تعدد سائر المجموعات اليهودية فى «المدينة»، ثم أضافت شيئًا مهمًا آخر، حيث نصت: «وأنه لا يخرج أحد منهم -من «المدينة» – إلا بإذن محمد».
وهذا ليس تقييدًا لحريتهم، وإنما هو إجراء وقائى اقتضته ظروف الدولة الناشئة؛ خوفًا من عمليات التجسس، ونقل أخبار الدولة إلى أعدائها، وبخاصة أنها تعتبر فى حالة حرب مع «قريش»، التى أجبرت المسلمين على ترك أوطانهم وديارهم وأموالهم.
وهذه المعاهدة كانت مهمة وأساسية فى إعلان ميلاد دولة المسلمين بقيادة النبى – صلى الله عليه وسلم -، باعتراف جميع أطرافها بهذه القيادة، كما يفهم من عبارة النص الآتى: «وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده، فإن مرده إلى الله عز وجل، وإلى «محمد» رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، وأن الله على أتقى ما فى هذه الصحيفة وأبره».
وعلى هذه الأسس الثلاثة السابقة قامت الدول الإسلامية فى «المدينة»، وكان فى قيامها فتح جديد فى الحياة السياسية؛ إذ قررت حرية الاعتقاد والرأى، وحرمة «المدينة»، وحرمة الحياة، وحرمة المال، وحددت أعداء الدولة فى صراحة ووضوح، فمنعت إجارة «قريش» ومن نصرها.
حكومة الرسول:
كان النبى – صلى الله عليه وسلم – أول رئيس للدولة الإسلامية، كما نصت على ذلك المعاهدة، وقد قام النبى – صلى الله عليه وسلم – بهذه المهمة طوال حياته، فهو الذى يقضى فى الحقوق المدنية والجنائية كافة، وينفذ القضاء، ويقيم الحدود، ويجبى الأموال من مواضعها الشرعية، ويوزعها فى مصارفها الشرعية، ويعلن الحرب، ويعقد معاهدات الصلح، ويخاطب رؤساء الدول، ويستقبل سفراءهم، ويولى الولاة على الأماكن البعيدة عن «المدينة».
إقرأ أيضا:خلافة علي بن ابى طالبوهو فى ذلك كله مؤيد من الله – تعالى – فإذا نزلت الحادثة بالأمة، ولم يكن نزل فى شأنها وحى من الله، اجتهد النبى رأيه وشاور أصحابه من أهل العلم والرأى، وكانوا تارة يجمعون على رأى فيعمل به، وتارة يختلفون فيعمل برأى بعضهم، ويترك رأى البعض الآخر، مجتهدًا فى ترجيح رأى على رأى.
ولما كانت أعباء الدولة كثيرة، وفى الوقت نفسه يقوم بمهمة تبليغ الرسالة، وهى مهمة ثقيلة، فقد احتاج إلى معاونة أصحابه فى إدارة الدولة، ومنهم تشكَّلت حكومته واختص بعضهم بملازمته، مثل «أبى بكر الصديق»، و «عمر بن الخطاب»،فأطلق عليهم «وزراء الرسول»، وكان له «صاحب سر»، أشبه ما يكون بالسكرتير الخاص، إن صح هذا التعبير، هو «حذيفة بن اليمان»، و «صاحب شرطة» هو «قيس بن سعد بن عبادة».
وكان له عدد من الحرَّاس، منهم: «سعدُ بن زيد الأنصارى»، و «الزبير بن العوام».
وكان له عدد من الحجَّاب الذين يستأذنون للناس فى الدخول عليه، منهم: «أنس بن مالك».
وكان له خاتم لختم الرسائل والمعاهدات، يحمله اثنان هما: «حنظلة بن الربيع بن صيفى»، و «الحارث بن عوف المرِّى».
واختص بعض الصحابة باستقبال الوفود التى تأتى لمقابلة الرسول – صلى الله عليه وسلم -، فيعلمونهم كيف يحيونه، وينزلونهم فى بيت الضيافة الذى كان من السعة بحيث اتسع لبنى قريظة، وكانوا زهاء ستمائة رجل أثناء انتظارهم للمحاكمة بعد خيانتهم فى غزوة «الأحزاب».
وكان للرسول عدد من الكتاب تجاوز الأربعين كاتبًا، منهم «أبو بكر الصديق»، و «عمر بن الخطاب»، و «عثمان بن عفان»، «وعلى بن أبى طالب»، و «الزبير بن العوام» و «خالد» و «أبان» ابنا «سعيد بن العاص»، وغيرهم، واختص بعض هؤلاء بكتابة الوحى، وبعضهم الآخر بالكتابة فى الشئون العامة للدولة.
وكان له عدد كبير من السفراء، يرسلهم فى مهام إلى الملوك والرؤساء وزعماء القبائل، وحرص الرسول على تعليم بعضهم اللغات الأجنبية، إذ كانت تأتيه مراسلات بتلك اللغات، ومن هؤلاء «زيد بن ثابت الأنصارى»، وكان يجيد الفارسية والعبرية، وبعضهم كان يعرف إلى جانب لغته العربية خمس لغات هى الفارسية والعبرية واليونانية والسريانية والحبشية.
وامتلك النبى – صلى الله عليه وسلم – جهازًا إعلاميا قوامه الشعراء، مثل: «حسان بن ثابت»، و «عبدالله بن رواحة»، و «كعب بن مالك»، وكانوا يردون على شعراء المشركين حين كانوا يهاجمون النبى – صلى الله عليه وسلم – ويهجونه.
وللنبى – صلى الله عليه وسلم – جهاز دقيق لجمع المعلومات عن الأعداء، وهو ما يقابل الآن جهاز المخابرات فى الدول الحديثة، وكان جهازًا فعالا، ومن رجاله: «بَسبَسة بن عمرو الجُهنى»، و «طلحةُ بن عُبيدِ الله»، و «سعيد بن زيد»، و «عبد الله بن أبى حدرد الأسلمى».
مشروعية القتال فى الإسلام:
تقطع آيات القرآن الكريم وأحاديث النبى – صلى الله عليه وسلم -، وتصرفاته العملية بأن السلام هو الأصل والقاعدة الأساسية فى علاقات المسلمين بغيرهم من الأمم، وأن الحرب هى الاستثناء، فالحرب فى الإسلام ليست غاية، وإنما هى وسيلة لتحقيق السلام،فإذا مال أعداء المسلمين إلى السلم وعزفوا عن الحرب، فعلى المسلمين أن يستجيبوا لهم فورًا؛ لقوله تعالى: {فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا}. [النساء:
من90].
وقال تعالى: {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكَّل على الله}.
[الأنفال: من 61].
وتنحصر مسوغات الحرب فى الإسلام أو أسبابها المشروعة فى ثلاث حالات هى:
– الدفاع عن النفس:
وهو عمل مشروع، أقرته الشرائع السماوية كافة، وكفلته القوانين الوضعية، وحددته الآية السابق ذكرها: {وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لايحب المعتدين}. [البقرة:190].
– والدفاع عن حرية نشر العقيدة:
لأن العقيدة ذاتها لا تحتاج إلى قوة لنشرها إذا خلت الطريق أمامها من العوائق، ولم يحاربها الطغاة، وتركوها تشق طريقها إلى قلوب الناس فى حرية وأمان وفى هذا يقول الله تعالى:
{وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله}. [الأنفال: من 39]. – الدفاع عن المظلومين:
وهذا واجب إنسانى على المسلمين، فمن أهداف الإسلام نصرة المظلومين ودفع الظلم عنهم، يقول الله تعالى: {وما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها}. [النساء: من 75]. ولم يأذن الله – تعالى – للمسلمين فى القتال، إلا بعد أن تعرضوا للظلم، وتحملوا شتى ألوان الاضطهاد والتعذيب، وطُرِدوا من بلدهم، وأخرجوا من ديارهم، وصودرت أموالهم وعندئذٍ كان لابد من الدفاع، وجاء الإذن به من السماء فى قوله تعالى: {أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله .. }. [الحج: 39 – 40].
آداب الحرب فى الإسلام:
هى مجموعة القواعد والمبادئ والتقاليد العسكرية، التى أرساها الإسلام، وطبقَّها النبى – صلى الله عليه وسلم – بنفسه، وكانت تعليماتهووصاياه لقواده العسكريين، تدور فى نطاقها.
فيحتم الإسلام على المسلمين الاعتناء بجرحى أعدائهم ومداواتهم وإطعامهم (4)، ويحرم الإجهاز عليهم أو إيذاؤهم بأى شكل من أشكال الإيذاء.
كما يفرض على المسلمين تجنيب المدنيين شرور الحرب وأخطارها، فالأطفال وكبار السن، والنساء والمرضى، بل الفلاحون فى حرثهم والرهبان فى معابدهم، كل أولئك معصومون بحصانة الشريعة من أخطار الحرب.
والإسلام لا يحرص على سلامة أرواح غير المقاتلين من الأعداء فحسب، بل يوصى المسلمين المقاتلين بعدم التعرض للأهداف المدنية، وينهاهم عن التدمير؛ لأن الإسلام إنما جاء ليبنى الحياة ويعمرها، لا ليدمرها ويهدمها.
وكان الرسول – صلى الله عليه وسلم – نفسه المثل الأعلى فى الالتزام بهذه المبادئ والآداب فى ميادين القتال، فروى «أبو ثعلبة الخشنى» رضى الله عنه:
«إن ناسًا من اليهود يوم خيبر جاءوا إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بعد تمام العهود، فقالوا: إن حظائر لنا وقع فيها أصحابك، فأخذوا منها بقلا وثومًا، فأمر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – «عبد الرحمن بن عوف» – رضى الله عنه – فنادى فى الناس: إن رسول الله يقول لكم: لا أحل لكم شيئًا من أموال المعاهدين إلا بحق».
غزوات الرسول – صلى الله عليه وسلم -:
لم يكن أمام النبى – صلى الله عليه وسلم – بد من اللجوء إلى القوة العسكرية إزاء الغطرسة القرشية واضطهاد المسلمين، وإخراجهم من ديارهم قسرًا، وملاحقتهم بالأذى وهم فى مهاجرهم فى «المدينة»، بالإضافة إلى مؤامرات اليهود وغدرهم وخياناتهم.
من أجل ذلك كله أعد الرسول – صلى الله عليه وسلم – جيشًا قويا من المجاهدين فى سبيل الله، وقاد بنفسه سبعًا وعشرين غزوة، قاتل فى تسع منها، هى: «بدر»، و «أحد»، و «الأحزاب»، و «بنو قريظة»، و «بنو المصطلق»، و «خيبر»، و «فتح مكة»، و «حنين»، و «الطائف»، وأناب بعض أصحابه فى قيادة سبع وأربعين حملة عسكرية.وعلى الرغم من هذا العدد الكبير من الغزوات والحملات فإن عدد الضحايا فيها كلها من الفريقين كان قليلا جدا، لا يتجاوز أربعمائة قتيل، وكان شهداء المسلمين فى تلك المعارك نحو مائتى شهيد، منهم سبعون قتلوا غدرًا فى «بئر معونة»، فى حين لم يتجاوز قتلى المشركين المائتين أيضًا، وهذا يدل على حرص النبى – صلى الله عليه وسلم – على حقن الدماء، وصيانة الأرواح، وحصر الحرب فى أضيق نطاق ممكن.
وسنتناول بالدراسة أهم الغزوات ذات الأثر الكبير والحاسم فى تاريخ الإسلام، وهى:
1 – غزوة بدر الكبرى:
وقعت هذه الغزوة الخالدة فى السابع عشر من شهر رمضان المبارك من السنة الثانية من الهجرة عند بئر بين «مكة» و «المدينة»، وقد سمى الله – تعالى – يومها «يوم الفرقان»؛ لأنه فرَّق بين الحق والباطل، وأعلى كلمة الإسلام.
وسببها أن قافلة تجارية لقريش، كانت قادمة من «الشام» إلى «مكة»، فأمر النبى – صلى الله عليه وسلم – أصحابه بالتعرض لها والاستيلاء عليها؛ تعويضًا لهم عن أموالهم التى استولت «قريش» عليها فى «مكة»، وهذا حق وعدل، ولم يكن فى وسع الرسول – صلى الله عليه وسلم – أن يترك «قريشًا» حرة طليقة، تجوب الطرق، وتتجر وتربح، وتعيش آمنة مطمئنة، وهى التى آذته وعذبت أصحابه، وتآمرت على حياته، وأرادت قتله، فلابد من التضييق عليها، وتهديدها فى تجارتها التى هى رزقها ومصدر قوتها؛ لتراجع نفسها، وتقتنع بأن مواصلة العداء معه ليس فى مصلحتها، ولم يقصد الرسول – صلى الله عليه وسلم – بهذا التصرف إهلاك «قريش» وتدميرها، لأنه جاء لإحيائهم وإسعادهم.
وعندما وصل النبى – صلى الله عليه وسلم – بجيشه إلى المكان الذى دارت فيه المعركة علم أن القافلة أفلتت ونجت، بعد أن نجح قائدها «أبو سفيان بن حرب» فى اتخاذ طريق الساحل بعيدًا عن طريق القوافل المعتاد، حين علم بخروج المسلمين للاستيلاء عليها، وكان قبل أن يفلت بقافلته قد أرسل سريعًا إلى «قريش» يستنفرهاللخروج لاستنقاذ أموالها التى توشك أن تقع فى أيدى المسلمين
فخرجت فى نحو ألف رجل للقتال، وأصروا على ذلك حتى بعد أن علموا بنجاة قافلة «أبى سفيان»، وقد حاول بعض زعماء «مكة» مثل «عتبة بن ربيعة» أن يقنعوهم بالرجوع وعدم المضى قدمًا فى الحرب، وبخاصة أن المسلمين الذين سيقاتلونهم هم أهلوهم ففيهم الآباء والأبناء والأعمام والأخوال والإخوة، لكن تلك الدعوة فشلت أمام إصرار أئمة الكفر – وعلى رأسهم «أبو جهل» – على إشعال نار الحرب، حيث أراد هو وأمثاله أن يجعل من خروجهم مظاهرة عسكرية؛ فأقسم على الذهاب إلى «بدر»، ونحر الجزور، وشرب الخمور، والاستمتاع بالرقص والغناء؛ لتسمع بهم العرب، فيهابوهم أبد الدهر.
المواجهة العسكرية:
عندما علم المسلمون بإفلات القافلة، رأى بعضهم العودة إلى «المدينة»، لأن كثيرًا ممن خرجوا لم يكن فى حسبانهم أنهم خرجوا لقتال وأن حربًا ستقع، وإنماخرجوا للاستيلاء على القافلة، فكرهوا القتال.
لكن الرسول – صلى الله عليه وسلم – كان يعلم أن الرجوع إلى «المدينة» ستفسره «قريش» على أنه جبن وضعف عن لقائها ومواجهتها، وسوف تذيع ذلك فى أوسع نطاق ممكن من شبه الجزيرة العربية، وفى هذا ضرر بالغ بالدولة الإسلامية ودعوتها، فتصرف الرسول – صلى الله عليه وسلم – بحكمة بالغة وبعد نظر، واستشار كبار أصحابه فيما يصنعون، فتحدث «أبو بكر الصديق» و «عمر بن الخطاب» وغيرهما فأحسنوا الكلام، وأبدوا استعدادًا للتضحية والجهاد فى سبيل الله.
سمع الرسول – صلى الله عليه وسلم – كلامهم فسعد به وسُرَّ، لكنه لا يزال فى حاجة إلى معرفة رأى الأنصار فى وضوح وجلاء، لأن بيعتهم معه كانت تنص على الدفاع عنه داخل «المدينة» لا خارجها، فلما كرَّر قوله: «أشيروا علىَّ أيها الناس»، قال له: «سعد بن معاذ» وغيره من زعماء الأنصار: «لعلك تقصدنا يارسول الله»، قال: «نعم».
قالوا: «يا رسول الله، آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هوالحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضِ بنا يا رسول الله لما أردت، فنحن معك، فوالذى بعثك بالحق، لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدًا، إنا لصبر فى الحرب، صدق عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر على بركة الله».
اطمأن الرسول – صلى الله عليه وسلم – لموقف أصحابه وسلامة جبهتهم، وقوة ترابطهم، وبدأ يُعدُّ للمعركة الأولى فى تاريخ الإسلام، وأعدَّ له المسلمون عريشًا (مقر قيادة) يدير منه المعركة.
وعرف الرسول – صلى الله عليه وسلم – عدد أعدائه وقوتهم من عيونه ومخابراته العسكرية فكانوا نحو ألف رجل مدججين بالسلاح، فيهم عدد كبير من الفرسان، فى حين كان عدد المسلمين نحو ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا، فيهم فارسان فقط.
وبدأت المعركة صبيحة اليوم السابع عشر من شهر رمضان سنة (2هـ) بالمبارزة، حيث خرج ثلاثة من صفوة المشركين، هم «عتبة بن ربيعة»، و «شيبة بن ربيعة»، و «الوليد بن عتبة»، يطلبون المبارزة، فأمر النبى – صلى الله عليه وسلم – عمه «حمزة»، وابنى عمه «على بن أبى طالب»، و «عبيدة بن الحارث» بالخروج إليهم، وهذا تصرف له مغزاه من القائد الأعلى «محمد» رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، حيث بدأ المعركة بأقرب الناس إليه، فضرب المثل فى التضحية والفداء لدين الله، واستطاع الثلاثة المسلمون القضاء على الثلاثة المشركين من أعدائهم، وتركوهم صرعى فى ميدان المعركة، ثم احتدمت الحرب، وتلاحم الناس، وحمى الوطيس، والرسول فى عريشه يدعو الله سبحانه وتعالى ويستنزل نصره الذى وعده به، فيقول:
«اللهم نصرك الذى وعدتنى، اللهم إن تهلك هذه العصابة من المسلمين فلن تُعبَد على وجه الأرض، يامولاى»، واستجاب الله لدعاء نبيه، وانجلت المعركة عن نصر ساحق للمسلمين، وهزيمة ماحقة للمشركين الذين قُتِلَ منهم سبعون، وأُسِرَ مثلهم، وفر الباقون، وامتلأت أيدىالمسلمين من غنائمهم التى تركوها، واستُشهد من المسلمين أربعة عشر شهيدًا، وتحقق وعد الله، فنصر القلة القليلة المؤمنة، على الكثرة المشركة المتغطرسة.
الغنائم والأسرى:
بينما كان حزن «قريش» طاغيًا على هزيمتها ورجالها الذين فقدتهم فى المعركة بين قتيل وأسير، كانت فرحة المسلمين عظيمة لهذا النصر المؤزر، وعادوا إلى مدينتهم يتقدمهم رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، يحملون الغنائم، ويسوقون الأسرى المقيدين بالأغلال، ومع ذلك فقد أمر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – المسلمين أن يحسنوا معاملة الأسرى وإطعامهم.
أما الغنائم فقد أنزل الله على رسوله حكم التصرف فيها فى سورة «الأنفال»، التى نزلت بشأن هذه المعركة، فقضى عز وجل بأن تقسم الغنائم خمسة أقسام، خُمس للرسول، يتصرف فيه كيف يشاء فى الأمور التى حددتها الآية الكريمة، فى حين توزع الأربعة الأخماس على المجاهدين، للراجل سهم، وللفارس سهمان.
أما الأسرى، فقد استشار النبى – صلى الله عليه وسلم – فيهم أصحابه، فمنهم من أشار بقتلهم؛ لأنهم عذَّبوا المسلمين وطردوهم من ديارهم وعلى رأس هذا الفريق «عمر بن الخطاب»، ومنهم من قال:
يارسول الله هم أهلك وعشيرتك، فاستبقهم وخذ منهم فداء، تتقوى به على قتال أعدائنا. وكان على رأس هذا الفريق «أبو بكر الصديق»، فمال النبى – صلى الله عليه وسلم – إلى الرأى الأخير، وقبل منهم الفداء، وكان كريمًا معهم، فقد أطلق سراح الفقراء منهم بدون مال، وطلب ممن يعرف القراءة والكتابة منهم أن يعلم عشرة من أطفال المسلمين، ويكون هذا فداءً له، وهذا تصرف رائع من الرسول – صلى الله عليه وسلم – له دلالة عظيمة على عناية الإسلام بالتعليم، فهذه أول حادثة من نوعها فى تاريخ البشرية، فلم يُعرف أن فاتحًا منتصرًا قبله صنع مثل هذا الصنيع.
عوامل النصر فى بدر:
أما عن أهم العوامل التى أدت إلى هذا النصر فى أول معركة كبرى بين المسلمين والمشركين، فهى:
– القيادة:
كان الرسول – صلى الله عليه وسلم – نعم القائد، فقد استعد جيدًا للمعركة، وأدارها بكفاءة عالية فى ظل الإمكانات المتاحة، وجعل أصحابه يبذلون طاقاتهم كلها فى الدفاع عن دين الله، فكان يستشيرهم فى كل أمر ويتقبل آراءهم واقتراحاتهم، ولا يتميز عنهم فى أى شىء، حتى إنه تناوب الركوب على بعير واحد مع «على بن أبى طالب»، و «مرثد بن أبى مرثد الغنوى».
وكان لهذه الأسوة الحسنة من رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أثرها الكبير فى نفوس أصحابه، حبًا لله ولرسوله لا ينازعه شىء، وطاعة للأمر مهما يعظم، وسرعة فى تنفيذه، ودفاعًا عن دين الله ودعوة رسوله بكل ما يملكون.
– العقيدة الراسخة:
كان للإيمان والثقة بنصر الله أثر بالغ فى النصر، فلم يتهيبوا الحرب أبدًا، مع أنهم كانوا يعلمون أن قوة عدد المشركين ثلاثة أمثال قوتهم.
– المعنويات العالية:
تمتع المجاهدون المسلمون فى «بدر» بمعنويات استمدوها من الإيمان بالله، والثقة بنصره، ومن عظمة القائد وحكمته فى إدارة المعركة، ولا شك أن المعنويات العالية تُعدُّ من أهم عوامل النصر فى كل الحروب، فقد دلت التجارب أن قوة التسلح، وكثرة العدد لا تجديان ما لم يتحل المقاتلون بمعنويات عالية.
2 – غزوة أحد:
وقعت هذه الغزوة فى شهر شوال من العام الثالث للهجرة عند جبل «أحد»؛ شمالى «المدينة المنورة»، فقد جندت «قريش» ثلاثة آلاف من رجالها وحلفائها للانتقام من المسلمين، والثأر لهزيمتها الساحقة فى «بدر» التى جلبت فى كل بيت من بيوت «مكة» مأتمًا.
وعندما وصلت أخبار ذلك إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم -؛ جمع أصحابه على الفور، واستشارهم فى أفضل طريقة لمواجهة هذا الموقف، فأشار عليه شيوخ «المدينة» أن يتحصنوا داخلها، ويتركوا الأعداء خارجها لأن شوارع «المدينة» ضيقة، ويمكن إغلاقها عليهم، وقتالهم فيها بكل طريقة ممكنة حتى بالحجارة، ويمكن أن يشترك النساء والأطفال فى مقاومتهم، وكان هذا رأى الكبار ورأى النبى- صلى الله عليه وسلم -. أما الشباب فقد أخذهم الحماس، وخشوا أن يتهمهم الأعداء بالجبن؛ ففضلوا الخروج لمواجهتهم فى مكان مكشوف.
ولما رأى الرسول – صلى الله عليه وسلم – أن الرأى الأخير هو رأى الأغلبية قام إلى بيته ولبس درعه وحمل سلاحه وخرج إليهم، فأدركوا أنهم أخرجوه مكرهًا، فقالوا له: يارسول الله، لقد استكرهناك وما كان لنا ذلك، فافعل ما شئت، فقال – صلى الله عليه وسلم -: «ماكان لنبى لبس لأمته – عدة حربه – أن ينزعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه».
وخرج النبى – صلى الله عليه وسلم – إلى ساحة «أحد»، وجعل ظهر جيشه إلى الجبل، والأعداء أمامه، ونظر إلى ميدان المعركة نظرة فاحصة، وعرف أن الخطر يكمن خلف ظهر الجيش، فأعد خمسين رجلا ممن يُحسنون الرمى بالنبل، وأمَّر عليهم «عبدالله بن جبير الأنصارى»، وكلفهم بالصعود إلى قمة عالية خلف ظهورهم، سُميت بعد ذلك بجبل الرماة، وقال لهم فى حسم: «احموا ظهورنا، لأنُؤتى من قبلكم»، وأمرهم برمى المشركين بالنبال، وألا يتركوا مواقعهم أبدًا سواء انتصر المسلمون أو انهزموا، لخطورة الموقع وأهميته، وكرر عليهم أوامره مرارًا.
ودارت المعركة، وكانت الغلبة للمسلمين فى البداية، لكنهم تعجلوا النصر ولم يصبروا، وظنوا أن المعركة انتهت، فالذين فى الميدان تركوا القتال وبدءوا فى جمع الغنائم، والذين فوق الجبل خالفوا أوامر النبى – صلى الله عليه وسلم – وأوامر قائدهم «عبدالله بن جبير»، وتركوا مواقعهم، ليشتركوا فى جمع الغنائم.
انتهز «خالد بن الوليد» هذه الفرصة، وانقض بفرسانه من الخلف، مستغلا الثغرة التى حدثت بترك الرماة مواقعهم، فحول بحركته العسكرية سير المعركة من نصر للمسلمين فى أولها إلى هزيمة، وارتبك المسلمون من هول المفاجأة، حتى إن بعضهم أخذ يقتل بعضًا، وزاد ارتباكهم عندما أشاع المشركون أنهم قتلوا الرسول – صلى الله عليه وسلم – الذى كان قد سقط فى حفرة، وجُرِح وكُسِرَترباعيته، وانجلت المعركة عن هزيمة للمسلمين، وسقوط واحد وسبعين شهيدًا، وكان ذلك درسًا قاسيًا، أنزل الله بشأنه أكثر من ستين آية فى سورة «آل عمران»، وضح لهم أسباب ما حدث، وأن الهزيمة إنما كانت لمخالفة أوامر الرسول، والحرص على جمع الغنائم، قال تعالى: {ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين}. [آل عمران: 152].
ثم واساهم وعفا عنهم، وذكرهم بأنهم إن كانوا قد أصابهم قرح وخسروا معركة، فقد أصاب أعداءهم قرح مثله {وتلك الأيام نداولها بين الناس}، ثم طلب من نبيه أن يعفو عنهم ويستغفر لهم، وألا يدع مشورتهم، حتى لو أدت إلى الهزيمة فى معركة، فخسارة المعركة أسهل من خسارة مبدأ الشورى الذى يربى الرجال ويدربهم على إبداء الرأى والمشاركة فى صنع القرار.
3 – غزوة الأحزاب:
أظهر يهود «بنى قينقاع» بعد غزوة «بدر» تصرفات بالغة السوء، وأظهروا حزنًا شديدًا على هزيمة «قريش»، وساءهم انتصار المسلمين، وكان ذلك خيانة ونقضًا للمعاهدة التى وقعها الرسول معهم، كما أنهم أرسلوا وفدًا إلى «مكة» لمواساتها، وهذا يخالف ما اتفق عليه فى معاهدة «المدينة» التى نصت فى أحد بنودها على عدم إقامة أية علاقات مع «مكة»، ثم أساءوا إلى المسلمين وانتهكوا حرماتهم، كما أغلظوا القول لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – حين نصحهم بالاستقامة والالتزام بنصوص المعاهدة، وقالوا:
«يا محمد لا يغرنك أنك لقيت قومًا لا علم لهم بالحرب – يقصدون «قريشًا» – فلو حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس»، ولم يجد الرسول – صلى الله عليه وسلم – بدا إزاء تصرفاتهم هذه إلا أن يجلوهم عن «المدينة» ويتخلص من غدرهم وأذاهم، ثم أجلى الرسول بعد غزوة أحد يهود «بنى النضير» بعد أن دبروا مؤامرة لقتله، فحقد اليهودعليه، وألبوا «قريشًا» وحلفاءها لشن حرب شاملة ضد المسلمين، وذهب وفد منهم لهذه المهمة بزعامة «حيى بن أخطب» إلى «مكة»،ووعدوهم بمساعدتهم، وقالوا لهم إنهم اتفقوا مع يهود «بنى قريظة» – الذين كانوا لا يزالون يسكنون «المدينة» – على الانضمام إليهم عندما يهاجمون المسلمين فاقتنعت «قريش» بذلك، ثم ذهبوا إلى قبائل «غطفان» و «بنى أسد»، وصنعوا معهم مثلما صنعوا مع «قريش»، ونجحت خطتهم الخبيثة بأن تجمع جيش من عشرة آلاف مقاتل، من «قريش» وحلفائها، و «غطفان» و «بنى أسد» لمهاجمة «المدينة»، وكان ذلك فى شهر شوال من السنة الخامسة للهجرة.
حفر الخندق:
علم الرسول – صلى الله عليه وسلم – بهذه الأخبار المفزعة، فجمع كبار الصحابة واستشارهم كيف يواجهون هذا الموقف، فأشاروا عليه بالتحصن داخل «المدينة»؛ لأنهم استفادوا من درس «أحد»، وأخذوا يعدُّون العدة لتحمل حصار طويل من الأعداء. وهنا جاءت فكرة رائعة من «سلمان الفارسى» – رضى الله عنه – وهى حفر خندق فى الجهة الشمالية الغربية من «المدينة»؛ لمنع اقتحام جيوش الأحزاب لها، لأن بقية جهاتها الأخرى كانت محصنة بغابات من النخيل، يصعب على الخيول اقتحامها.
وتم حفر الخندق فى نحو أسبوع، وعمل النبى – صلى الله عليه وسلم – بنفسه مع المسلمين فى حفره، وبشرهم وهم فى هذا الموقف العصيب بفتح «الشام» و «العراق» و «اليمن».
جاءت قوات الأحزاب وهى واثقة لا بالنصر على المسلمين فحسب، بل باستئصالهم، لكن المفاجأة أذهلتهم عندما رأوا الخندق يحول بينهم وبين اقتحام المدينة، وظلوا أمامه عاجزين، تأكل قلوبهم الحسرة، لأنهم لم يتعودوا مثل هذا الأسلوب فى القتال، ولما حاول واحد منهم اقتحام الخندق لقى حتفه فى الحال.
وعلى الرغم من أن الخندق قد حمى المسلمين من هجوم المشركين، فإن الكرب قد اشتد عليهم، وضاقوا بطول الحصار، وكانوا فى موقف عصيب بالغ الصعوبة، وصفه الله – تعالى – أدق وصف بقوله: {إذجاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدًا}. [الأحزاب:10 – 11].
اجتهد النبى – صلى الله عليه وسلم – فى تفريج الكرب عن المسلمين، فاتصل بقبائل «غطفان» وعرض عليها ثلث ثمار «المدينة» على أن يعودوا إلى ديارهم ويتخلوا عن «قريش» فوافقوا، وعرض الرسول – صلى الله عليه وسلم – هذا الأمر على الأنصار، فسألوه إن كان هذا أمرًا من الله فليس لهم أن يخالفوه، أما إذا كان اجتهادًا من أجلهم فلن يوافقوا عليه، فأعلمهم أنه اجتهاد منه لمصلحتهم ولتفريق الأحزاب عنهم، فأبوا وعزموا على مواصلة الجهاد والدفاع عن بلدهم، فأوقف النبى – صلى الله عليه وسلم – المفاوضات مع «غطفان» نزولا على رأى أصحابه.
ثم لاحت فرصة عظيمة عندما عرض «نعيم بن مسعود» – وكان قد أسلم وقدم مع الأحزاب دون أن يعلموا – أن يقوم بدور فى التخفيف عن المسلمين؛ فأمره الرسول – صلى الله عليه وسلم – أن يفرق بينهم وبين «بنى قريظة»، الذين نقضوا عهدهم مع النبى – صلى الله عليه وسلم – واتفقوا مع الأحزاب على الانضمام إليهم حين تبدأ الحرب.
وقد نجح «نُعيم» فى مسعاه نجاحًا عظيمًا، وزرع الشكوك فى قلوب الأحزاب و «بنى قريظة» تجاه بعضهم بعضًا، ثم أرسل الله ريحًا شديدة قلعت خيام المشركين، وكفأت قدورهم، وانقلب الموقف كله بفضل الله – تعالى – عليهم، وأدرك «أبو سفيان بن حرب» قائد الأحزاب ألا فائدة من البقاء، فأمرهم بالرحيل فرحلوا، وقد علق الرسول – صلى الله عليه وسلم – على هذا الموقف بقوله: «الآن نغزوهم ولا يغزوننا».أى أن قريشًا لن تستطيع مهاجمة «المدينة» مرة أخرى؛ لأن ميزان القوى أصبح يميل مع المسلمين.
عقاب بنى قريظة:
لما انسحبت الأحزاب، ونزع المسلمون لباس الحرب جاء «جبريل» – عليه السلام – إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، وقال: «يامحمدإن كنتم قد وضعتم سلاحكم، فما وضعت الملائكة سلاحها، إن الله يأمرك أن تخرج إلى «بنى قريظة»، فأمر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مناديًا ينادى فى الناس:
«لا يصلين أحدكم العصر إلا فى بنى قريظة»، وحاصرهم الرسول – صلى الله عليه وسلم – بضعة وعشرين يومًا، حتى نزلوا على حكمه، وطلبوا أن يحكم فيهم «سعد بن معاذ» حليفهم، فحكم بقتل الرجال منهم؛ جزاء غدرهم وخيانتهم، وانضمامهم إلى الأعداء وقت الحرب، فلو نجحت خطة الأحزاب لقُضِى على الإسلام والمسلمين قضاءً مبرمًا.
وحين قضى «سعد» بهذا الحكم، قال له رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «لقد حكمت فيهم بحكم الله».
4 – عمرة الحديبية:
قرر النبى – صلى الله عليه وسلم -، بعد هذه الحروب التى وقعت بينه وبين «قريش» أن يذهب هو وأصحابه إلى «مكة» لأداء العمرة فى شهر ذى القعدة من العام السادس للهجرة، لكن «قريشًا» رفضت رفضًا حاسمًا فيه غرور وغطرسة، مع علمها بأن الرسول إنما جاء «مكة» معتمرًا مسالمًا غير محارب، وليس من حقها أن تمنعه من زيارة البيت الحرام، الذى جعله الله للناس جميعًا مثابة وأمنًا، فعسكر الرسول – صلى الله عليه وسلم – فى «الحديبية» على مسافة قريبة من «مكة»، وجرت بينه وبينهم مفاوضات حرصًا منه على السلام وحقن الدماء، انتهت إلى عقد هدنة عُرِفت بصلح الحديبية، وأهم شروطها ما يلى:
1 – وقف الحرب بين الفريقين لمدة عشر سنين، يأمن فيها الناس ويسافرون وينتقلون فى أمان.
2 – وأن يعود الرسول وأصحابه هذا العام بدون أداء العمرة، وكانوا نحوًا من ألف وأربعمائة فرد، على أن يأتوا فى العام التالى، وتخلى لهم «قريش» «مكة» ثلاثة أيام يؤدون مناسكهم خلالها ثم يعودون إلى «المدينة».
3 – وأن من يأتى «مكة» مسلمًا بدون إذن وليه إلى «المدينة» يرده الرسول – صلى الله عليه وسلم – إليهم، أما من يأتى من المسلمين إلى «مكة» مرتدًا، فإنها ليست مطالبة برده إلى «المدينة».4 – وأن من أراد من القبائل العربية أن ينضم إلى أحد طرفى المعاهدة، فله ذلك (فانضمت قبيلة «خزاعة» إلى النبى – صلى الله عليه وسلم -، فى حين انضمت قبيلة «بنى بكر» إلى «قريش»).
وهذا الصلح كان فى ظاهره إجحافاً سياسياً للمسلمين، حتى إنه أثار اعتراضات بعض الصحابة، الذين رأوا فيه مهانة لهم، مثل «عمر بن الخطاب» -رضى الله عنه – غير أنه كان فى الحقيقة فتحًا مبينًا كما سماه الله -تعالى- فى سورة «الفتح» التى نزلت على الرسول – صلى الله عليه وسلم – وهو عائد من «الحديبية»؛ إذ كانت نتائجه فى مصلحة المسلمين، وكان تمهيدًا لفتح «مكة» بعد عامين اثنين.
5 – فتح خيبر:
وهى قرية كبيرة تقع شمالى شرقى «المدينة المنورة» بنحو مائة وثمانين كيلو مترًا، يسكنها بعض اليهود الذين لم تبد منهم أية إساءة إلى المسلمين من البداية، ولم يُسمع أن لهم ضلعًا فى أية مؤامرة أو موقف من مواقف اليهود المخزية ضد الرسول – صلى الله عليه وسلم – فاحترم الرسول موقفهم وحيادهم، غير أنهم تبدلوا وتغيرت مواقفهم.
منذ أن نزل عندهم يهود «بنى قينقاع» و «بنى النضير»، فأفسدوهم وجعلوا بلدهم وكرًا للتآمر على المسلمين والكيد لهم.
ولما كانت «خيبر» تقع على الطريق المؤدى إلى «الشام»، فكان لابد من تطهير ذلك الطريق من أية عوائق، وبخاصة أنه الطريق الرئيسى للدعوة الإسلامية وللجيوش الإسلامية التى ستخرج بعد وقت قصير لمواجهة دولة الروم، التى تكرر اعتداؤها على المسلمين؛ لذلك قرر الرسول – صلى الله عليه وسلم – تصفية آخر وكر يهودى فى شبه جزيرة العرب؛ لتسلم قاعدة الإسلام الأساسية ومنطلقه إلى العالم من عدو ماكر، فبعد عودته من «الحديبية» بأقل من شهر – أى فى المحرم من العام السابع للهجرة – غزا «خيبر»، ودك حصونها، فاستسلمت، وكان النبى – صلى الله عليه وسلم – كريمًا ورحيمًا مع أهلها، فلم يجبرهم على الدخول فى الإسلام، ولم يطردهم من بلدهم،بل أبقاهم يزرعون أرضهم، ولهم نصف محاصيلها، وللمسلمين النصف الآخر.
ولما سمعت القرى اليهودية الأخرى المنتشرة فى وادى القرى، مثل:
«فدك»، و «تيماء» بما حدث لخيبر، أرسلت وفودها إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يطلبون منه أن يعاملهم معاملته مع أهل «خيبر» فاستجاب لهم.
6 – فتح مكة المكرمة:
التزمت «قريش» بمعاهدة «الحديبية» لمدة عام وبعض العام، فقد ذهب الرسول – صلى الله عليه وسلم – وأصحابه لأداء عمرة القضاء فى العام السابع من الهجرة. لكنها ما لبثت أن نقضت المعاهدة عندما أعانت قبيلة «بنى بكر» حليفتها على قبيلة «خزاعة» حليفة رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، فطلبت «خزاعة» من الرسول نصرتها طبقًا للمعاهدة التى بينها وبينه، فوعدهم بالنصر، وبدأ فى الاستعداد لغزو «مكة».
شعر «أبو سفيان» زعيم «مكة» بالخطأ الفاحش الذى وقعوا فيه، فسافر إلى «المدينة» لمقابلة الرسول – صلى الله عليه وسلم – ولتجديد المعاهدة، فلم يقبل الرسول اعتذاره.
وفى بداية الأسبوع الثانى من شهر رمضان من العام الثامن للهجرة توجه الرسول – صلى الله عليه وسلم – على رأس جيش قوامه عشرة آلاف مجاهد لفتح «مكة»، وكان «أبوسفيان» يتوقع – منذ أن عاد من «المدينة» دون أن يحقق هدفه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – سيغزو «مكة»، ولكن لا يعرف متى يقع ذلك، فكان قلقًا ودائمًا يتحسس الأخبار.
وفى ليلة من الليالى رأى أبو سفيان نيران جيش النبى التى أوقدها المجاهدون فاستبد به الخوف والهلع، فسمع صوته «العباس بن عبد المطلب»، وكان قد خرج من «مكة» من قبل، والتقى بالنبى – صلى الله عليه وسلم – وأعلن إسلامه، فلما التقى بأبى سفيان أخبره بالجيش القادم لفتح «مكة»، ولا قبل لهم به، وأخذه إلى الرسول – صلى الله عليه وسلم – فأعلن إسلامه، وأعطاه النبى ميزة كبيرة، بناء على اقتراح من «العباس بن عبد المطلب»، ضمن الإعلان الذىأمره أن يبلغه لأهل «مكة»: «من دخل دار أبى سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن».
حرص النبى – صلى الله عليه وسلم – على دخول «مكة» بدون قتال، فهى بلد الله الحرام، وأحبُّ بلاد الله إليه، وفيها أهله وذووه، فكانت أوامره صريحة لجيشه، ألا يقاتلوا إلا إذا قوتلوا، وبالفعل دخل الجيش «مكة» فى العشرين من شهر رمضان دون قتال، إلا مناوشات بسيطة حدثت فى الجهة التى دخلت منها الفرقة التى كان يقودها «خالد بن الوليد» عند جبل «خندمة» فقضى عليها «خالد»، وكان قد أسلم هو و «عمرو بن العاص» بعد عمرة القضاء سنة (7هـ).
دخل النبى – صلى الله عليه وسلم – «مكة» فاتحًا منتصرًا، وهى التى طردته قبل ثمانى سنوات وتآمرت على حياته، فماذا هو فاعل بهؤلاء الذين عادوه وآذوه أذى شديدًا هو وأصحابه؟ وهل فكر فى الانتقام منهم؟ لم يحدث ذلك منه، بل جمعهم بعد أن دخل «الكعبة» وطاف بها، وكسر أصنامها بيده وهو يتلو: {وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقًا}.
وقال لهم: «ما تظنون أنى فاعل بكم؟» قالوا: خيرًا، أخ كريم وابن أخ كريم، قال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء».
وبهذا ضرب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أروع الأمثلة فى العفو والتسامح عندالمقدرة، فلم تحمله نشوة النصر وزهو القدرة على الانتقام ممن أساء إليه، بل نسى كل ما فعلوه معه ومع أصحابه من ألوان العذاب.