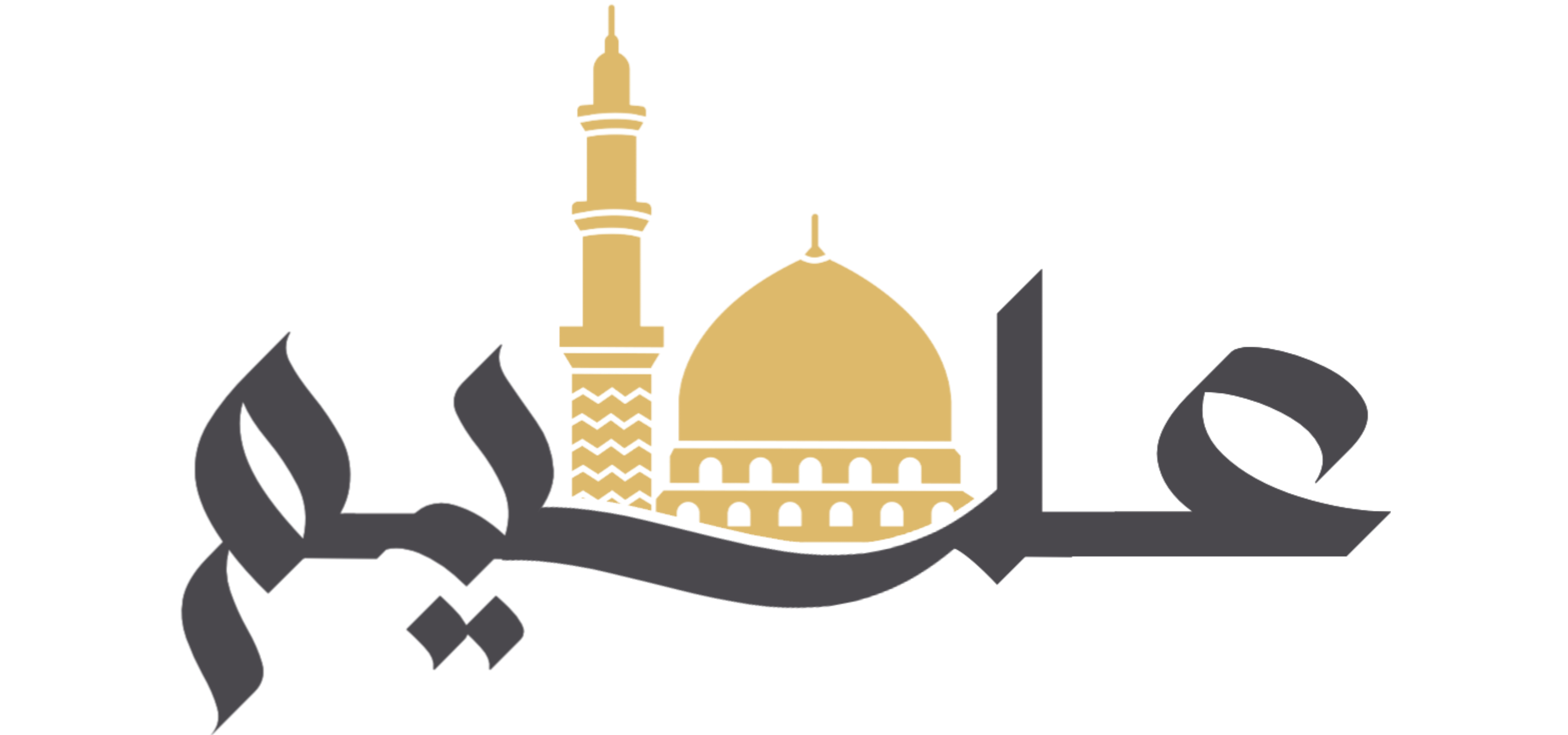( الله والإنسان.. مَن صَنع الآخر؟.. جدلية حيرت البشر منذ القدم، ومنذ أن وجدت الحياة على سطح الأرض.. ورغم أن الإيمان بوجود خالق للكون لازم أقدم الحضارات وظل الخطاب الإيماني هو الخطاب الأكثر استحواذا وقبولا، إلا أن الخطاب المنكر مارس حضورا واضحا، ودارت بين المؤمن والمنكر مساجلات وحوارات وصلنا عنها الكثير من المخطوطات التي سرعان ما تحوّلت إلى كتب تزخر بها المكتبات)
الناس جميعا أصحاب عقيدة ودين، على رغم أن الناس بين مؤمن بالله ومنكر له، لأن المؤمن يعتقد في قوة كبرى تسيّر الكون في عالم من الغيب اسمها الله، والمنكر يعتقد في الإنسان أو في مادة الطبيعة أنها في ذاتها نقطة البداية والنهاية، ويرى أن الله خرافة من صنع المؤمن به، فكلا الطرفين له اعتقاد ثابت، يدين الأول المؤمن لما يفوق الحواس ولا يحيط به الإدراك هو الله، ويدين الثاني المنكر لما يصيب ويخطئ وهو الإنسان، ولما يتشكل ويتغير وهو المادة، مساران وُجدا في الدنيا وسيظلان إلى نهايتها يمضيان.
بحث الإنسان عن الله منذ وُجد على الأرض، فأقدم الحضارات في بلاد العراق ومصر والهند شرقا، وفي اليونان غربا عرفت الإله، وإن اختلفت تصوراتها عنه، ففي حضارة الإغريق اليونانية بحث الفلاسفة عن الله، فمثلا: في تأملات أرسطو رأى أن كل شيء مسبب عن شيء آخر، فكل شيء يحدث له مُحدِث، وكل فعل له فاعل، ويستمر الأمر في سلسلة لا تنتهى من السببية؛ لذا تحدث أرسطو عن وجوب وجود سبب أول بلا مسبِب له، وضرورة أن يكون هناك فاعل أول لم يسبقه أحد.
إقرأ أيضا:هل الإيمان باليوم الآخر يؤثر على سلوك الإنسان؟وكانت مصر القديمة من أكثر أمم الشرق بحثا عن الله فما نقشه المصريون القدامى على جدران معابدهم من صور للميزان والحساب وحديث عن الحياة بعد الموت يُشعرك بعمق الإيمان المقدس الذى عرفه إنسان أقدم الحضارات، حتى قيل إن “برديات كتاب الموتى في الأهرامات هي بقايا صحف النبي إدريس عليه السلام.” فقضى قدماء المصريين حياتهم يشيدون قبورا لا تبلى إيمانا ببعث بعد الموت، وانشغلوا بتخليد آخرتهم عن دنياهم، فلم يبنوا الأهرامات ويشيدوا المعابد إلا بنزعة إيمانية، فكروا في عالم الغيب قبل أن يأتيهم علم الغيب عبر النبيين وحيًا، وكتب هيرودوت أقدم مؤرخي الإنسانية عن المصريين القدامى قوله: “أهم ما يميزهم عن غيرهم من الأمم أنهم أمة دَيِّنة“.
الله والإنسان.. أيهما صنع الآخر؟

لم يطرح الإنسان في الحضارات القديمة سؤال: الله أم الإنسان أيهما صنع الآخر؟ على نحو واسع، وسلّم بوجود قوة غيبية تكمن خلف الطبيعة تدير الكون اسمها إله.
ولم يطرح الإنسان في الحضارات القديمة سؤال: الله أم الإنسان أيهما صنع الآخر؟ على نحو واسع، وسلّم بوجود قوة غيبية تكمن خلف الطبيعة تدير الكون اسمها إله، ثم اختلفوا في تصوراتهم حول صفات الإله، وطبيعة علاقة هذا الإله أو تلك الآلهة بالإنسان، ووصلتنا آثار كثيرة من حضارات الأمم القديمة شرقا وغربا حول ذلك.
إقرأ أيضا:هل مِن صلة بين تعاليم الإسلام وتخلف أتباعه؟وتحوّلت بعض الحضارات القديمة من التصورات الوثنية لفكرة الإله إلى الديانة السماوية مثلما حدث من توجيه الإمبراطور الروماني قسطنطين الأول إلى المسيحية، ثم جاء الإسلام ليصنع أول مدينة تجمع قبائل العرب التي تعيش داخل الجزيرة العربية تحت لواء واحد، وتأسست الحضارة الإسلامية التي بدأت عربية ثم تعاقب عليها أعراق وأجناس مختلفة وحّدهم الدين الإسلامي، وظل الإيمان بالله هو الخطاب الأكثر استحواذا وقبولا، مع حضور للخطاب المنكر لله، ودار بين المؤمن والمنكر مساجلات وحوارات وصلنا عنها الكثير من المخطوطات التي سرعان ما تحوّلت إلى كتب تزخر بها المكتبات.
ثم جاءت الحضارة الحديثة واستطاع عقل الإنسان أن يخضع الكثير من الظواهر الطبيعية المعقَّدة للبحث العلمي الدقيق، وتعاظمت النظريات الفلسفية بعد أن حسمت موقفها من السؤال الحائر بين الشرق والغرب حول مَنْ صنع مَنْ؟ هل الإنسان صنع الله واخترع الدين؟ أم الله صنع الإنسان وأوحى إليه الدين عبر النبوة؟
وانحاز الغرب في غالبيته إلى الطرح الأول وهو أن الإنسان صنع الله، وانطلقت الفلسفات الحديثة تبدأ من الإنسان، وتنتهى إليه، وتجاهلت عالم ما وراء الطبيعة (ميتافيزيقيا)، أو ما يمكن أن نُطلق عليه رؤية الدين لعالمي الإنسان والطبيعة، وعلى الرغم من الإحصائيات العالمية التي تدرج الغرب ضمن الأعداد الهائلة المؤمنة بالمسيحية إلا أن الواقع يقول غير ذلك، فكثير منهم يؤمن بالإنسان والمادة، وينكر يسوع وما وعد به، ورغم تراجع المسيحية طوعا أو كرها عن الحياة العامة للغربيين مفسحة مساحات واسعة لاختيار الإنسان، بل وضامنة لهم مغفرة مسبقة للخطايا قدمها المسيح بدمه وآلامه من منظورهم.
إقرأ أيضا:هل مناسك الحج وثنية؟مهبط الديانات السماوية

في مقابل الموقف الغربي يأتي موقف الشرق منحازا في غالبيته إلى الإيمان بأن الله صنع الإنسان، وأوحى إليه دينا سماويا؛ فالشرق مهبط الديانات السماوية.
وفي مقابل الموقف الغربي يأتي موقف الشرق من سؤال “من صنع الآخر؟ الله أم الإنسان؟” منحازا في غالبيته إلى الإيمان بأن الله صنع الإنسان، وأوحى إليه دينا سماويا؛ فالشرق مهبط الديانات السماوية، وزاخر بالديانات الوضعية كما في الهند، فالإيمان بالنبوات والرسالات جزء أصيل في تكوين وجدان وفكر الشرق منذ القدم.
وبات إنسان الشرق مطالبا في العصر الحديث بأن يقدم رؤية فلسفية لعلاقة الإنسان بالله، وعلاقة كل منهما بالعالم، مستخدما لغة يفهمها الغربي، أو الشرقي المتأثر بالغرب، ولما كان الرد العلمي الذي يطلبه الغربي من إخضاع الغيبي غير المرئي لقواعد العلم التجريبي المحسوس المرئي غير ممكنة، كان البديل هو خطاب عقلي فلسفي ينطلق من العقل الإنساني والطبيعة ويناقش علل الأشياء والظواهر الكونية المحيطة به؛ ليصل من خلالها إلى الاستدلال العقلي على الله مستفيدا من المنجز العلمي الذي هو في حقيقته يعزِّز الإيمان بالله، لكن هذا لم يحدث؛ لأن العقل المسلم المعاصر يعيش قطيعة مع المدارس الفلسفية والعقلية التراثية من أمثال الغزالي وابن رشد وأبي حيان التوحيدي وابن سينا والفارابي والقاضي عبد الجبار، ويستحوذ عليه خطابات تقليدية تهمّش العقل، وتهمل دور الجانب العقلي في تعزيز الإيمان؛ لأنها تخاطب نفسها ولا تخاطب الآخر فتنطلق من النص وتجادل بالنص. وبين مدرسة الحديث المتمسكة بحرفية في قراءة لغة النصوص، ومدرسة الفقه المنشغلة بآيات الأحكام غاب إبراز رؤية القرآن للعالم، وللإنسان، وبات فراغا كبيرا في خطابنا الثقافي سببه غياب الرؤية الفلسفية للإسلام.
معاناة خطاب الثقافة العربية
عاش خطاب الثقافة العربية حالة من التمزق بين ما يردده النخب، وما يقتنع به الجماهير، فما يُعرف بالنخب الثقافية خاصمت الإسلام لمخاصمتها القائمين على الخطاب الإسلامي، وروّجت خطابا يتسق مع فلسفة الغرب المقصية لرؤية الدين للطبيعة والإنسان، غير أن هذا الخطاب لم يلق رواجا في الشارع العربي الذي شكّل دعاة الخطاب الإسلامي التقليدي وجدانه وفكره، وبات خطابهم أكثر استحواذا بعاطفته وأبجدياته السهلة، وزاد من ذلك تأثر المواطن بالخطاب الديني السمعي وباتت الخطب والدروس في المساجد المركزية وشريط الكاسيت الديني هو الوسيط السمعي الأكثر انتشارا، والمشكِّل الرئيسي في تكوين رؤية الشباب للدين، ثم كانت ظاهرة الفضائيات الدينية التي بدأت تدوير ما سبق إنتاجه من خطاب وعظي.
لم يستمر الأمر طويلا، فتكنولوجيا المعلومات أدت إلى انكماش الزمان والمكان، وجعلت العالم قرية صغيرة، وشكّلت العولمة المتعاظمة كل يوم من الثقافة الغربية ثقافة عالمية مركزية تهمّش ما عداها من الثقافات، واتخذ سؤال الغربي المنكر للأديان أشكالا مختلفة، وتولد من السؤال الواحد عشرات الأسئلة، أخذ يرددها الشرقي، وانتقل الخطاب من النخب الثقافية المتحدثة قديما همسا إلى حوارات شباب في حالة تفاعل دائم على حسابات التواصل الاجتماعي عبر هاتفه أو حاسوبه في عالم مفتوح لا يُجدي فيه العزل والمراقبة والحظر.
وأصبح العالم الإسلامي لاسيما العربي مستنزفا من تيارين مندفعين.. تيار إلحادي يستسلم لثقافة غربية تبدأ وتنتهى عند الإنسان.. منكرة لله، وتيار تكفيري يصطدم بمجتمعه لعلاقته بالغرب، ويتخذ من الغرب ساحة لقتال مفتوح، ويتبنى خطابا انعزاليا عدائيا يؤمن بحتمية الصراع.
وأمام تلك الخطابات المتنامية أصبح الخطاب الإسلامي التقليدي التلقيني بمفرده عاجزا؛ لأنه اعتاد أن ينطلق من النقل وليس من العقل لمخاطبة جماهير مؤمنة بالنصوص النقلية، وهو أمام جماهير جديدة لا تقبل الجلوس في موقع الجماهير بل ترى نفسها طرفا في جدل فكري، جماهير تكرر سؤالا مفاده: هل هناك أول قبل المادة وآخر بعد فنائها لا نريد أن نبحث عنه في النصوص المقدسة في نفوس المؤمنين بها، المشكوك في مصدرها في نفوس المنكرين لها، نريد أن نبحث عن الله في هذا الكون وبتلك النفس الباحثة بملكاتها العقلية والشعورية عن الحقيقة.
إننا بحاجة إلى أن نعزز حالة التساؤل، ونبدع في تنويع الإجابات، وإحالة المتسائل عن الغيب إلى الكون ينطلق من النظر فيه إلى معرفة الغيب، ونحن في هذا لا نبتدع منهجا بل هو القرآن الكريم في منهجه التحاوري الذي حكى لنا أسئلة المنكرين والمشككين وحكى لنا ردودها، نحن في حاجة لأن نفتح عقولنا وقلوبنا لكل صاحب سؤال نفكّر معه ما دام يبحث عن ربه بصدق.. فالله حكى في القرآن الكريم حوار نبيين –وهم المرسلون بالوحي- سألوا عنه “وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ. قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن. قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ” (البقرة:260).
“وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَٰكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ” (الأعراف: 143).
وهذا يحتاج أن ينطلق الخطاب الديني من العقل، وهو ما لا يتوقع صدوره من الخطاب التقليدي لأنه رغم حديثه عن التفكير لا يعدو كونه توصيفا إنشائيا يقف عند حدود الإطراء والمدح، ولا يتجاوزه إلى ممارسة عملية حقيقية؛ لذا فإن الخطاب التقليدي يحتاج أن يفسح مجالا لخطاب فلسفي يعزز من دور العقل، ويستفيد من تراث المدرسة الفلسفية الإسلامية العريقة التي فتحت بابا للتفكير والتساؤل المستمر، ويوظّف الأدوات والوسائل الحديثة لرصد الظاهرة وتوسيع دائرة النقاش حولها، وهو قادر على إحداث تراكم فكري معرفي يسد مساحات الفراغ في خطابنا الدعوي والثقافي، ويجعله قادرا على التصدي لموجات الإلحاد المندفعة بقوة من الثقافة العالمية، فالخطاب الفلسفي قادر على استعادة توازن الخطاب الدعوي أمام تلك الموجات لكن لا يُنتظر منه القضاء عليها؛ لأن خطاب الإيمان وخطاب الإلحاد سيظلان متوازيان في الثقافة الإنسانية المعاصرة ما بقي الشرق والغرب.