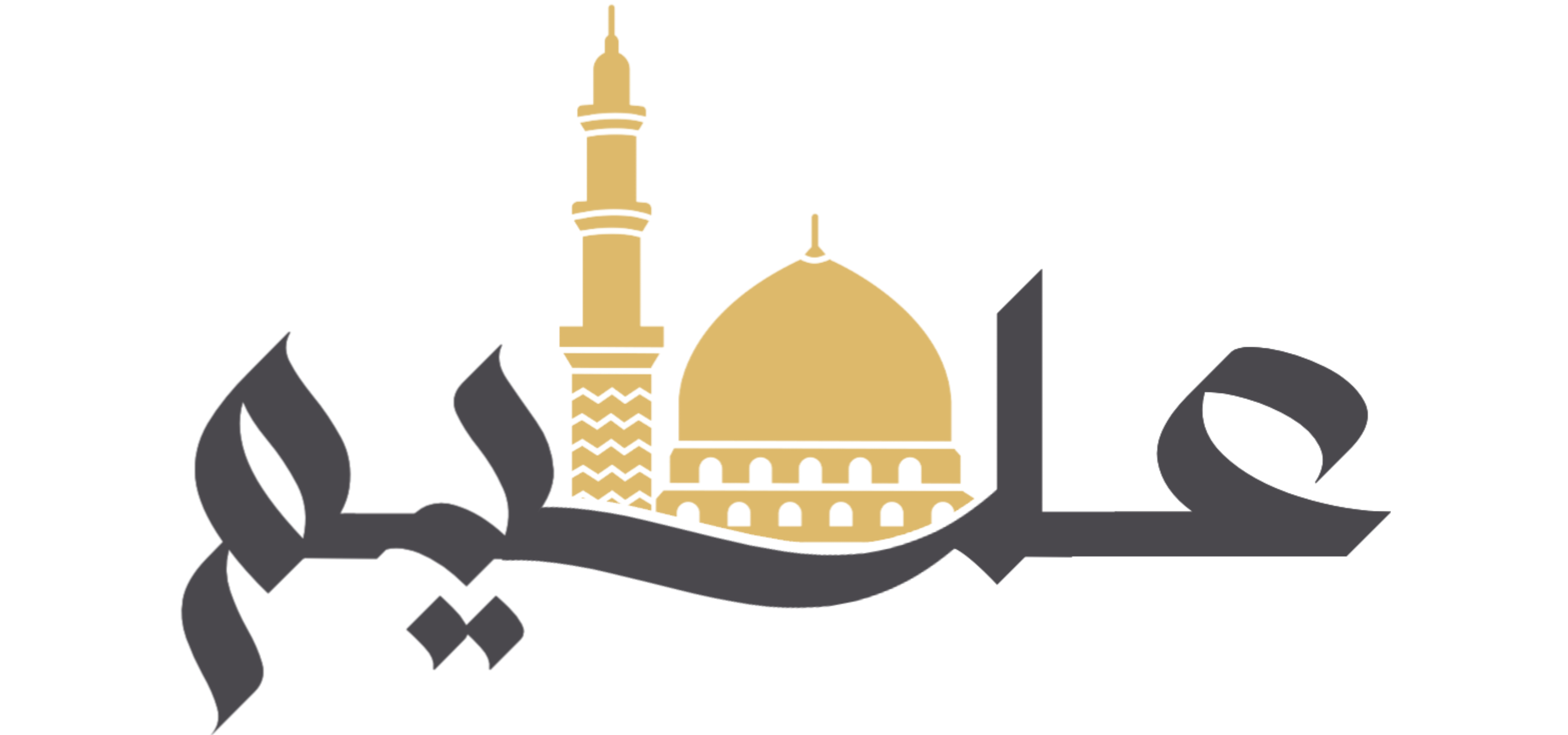المؤمن الصادق مثله مثل بقية البشر، يحركه دومًا الخوف أو الطمع أو كلاهما، ولكن الفارق الهائل بينه وبين غيره أنه يتوجه بخوفه وطمعه إلى الله وحده دون غيره، باعتباره هو وحده سبحانه الضار والنافع، لا أحد سواه…
(مقتطف من المقال)
د. حازم علي ماهر*
عصرنا الراهن وصناعة الكذب
في كثير من بلدان العالم لم يعد يأمن الناس حتى على أطفالهم من الخطف أحياء، لبيع أعضائهم الجسدية –بعد قتلهم- لمن يدفع أكثر، وهي حالات من المتوقع أن تتزايد مع الوقت للأسف الشديد، لا بشأن الأطفال وحدهم، بل بشأن البشر عمومًا، وخاصة الفقراء منهم!
علمنا -في المقال السابق- أن الخوف والطمع هما الباعثان الأساسيان على الصدق والكذب، وهذا أمر فطري، يتكرر في كل زمان ومكان، فلا يكاد يخلو عصر من العصور، أو وطنًا من الأوطان، من دواعٍ للخوف والطمع تترك أثرها على مصداقية الناس ودرجتها، وهو ما يمكن تسميته بالبيئة الأخلاقية المحيطة بالإنسان، والتي تؤثر في اختياره بين التحلي بالأخلاق الحسنة، وأساسها الصدق، أو السقوط في أسر الأخلاق المذمومة وعلى رأسها الكذب.
وإذا ما طبقنا هذه الحقيقة على عصرنا الراهن نستطيع أن نذهب بطمأنينة إلى أن هذا العصر هو عصر القلق والخوف وفقدان الأمن والأمان، فضلا عن كونه عصر الطمع كذلك، بمخاطبته لغرائز الإنسان وشهواته على حساب عقله وروحه، ومن ثم فهو يمثل بيئة دافعة للكذب، صانعة له، حائلة بين الإنسان وبين التزام الصدق في حياته الخاصة والعامة بسهولة ويسر.
إقرأ أيضا:الأخلاق.. دراسة و تحليل لأسباب التراجع و الانحدار (10)ففي هذا العصر حُرِم الإنسان –أو كاد أن يحرم- من الأمان الوظيفي، فهو إما عاطل لا يجد عملا أو مهدد بالبطالة نتيجة سياسات التقشف أو لاستبدال تقنيات جديدة به، وآخرها –مثلا- الإنسان الآلي الذي سيستطيع قريبًا أن يقوم بكثير من وظائف الإنسان الطبيعي الحالية، والتي عجزت أصلا عن أن تكفي كل الناس، فتفشت البطالة حتى في الدول الكبرى وإن بنسب أقل كثيرًا من الدول النامية.
وفي عصرنا هذا يعاني الإنسان كذلك من الفقدان المتزايد لدفء الأسرة النابع من تماسكها وتعاضدها، والتي باتت تتعرض -بشراسة- للتفكيك والانحلال، عبر التلاعب في الفطرة الإنسانية التي كانت مستقرة على أن الزواج هو بين رجل وامرأة، فإذا به يصبح كذلك بين رجلين، أو بين سيدتين، فضلا عن التلاعب في عملية الإنجاب والتناسل، بعد أن صارت الأرحام سلعًا يمكن استئجارها لفترة محددة، يستطيع الإنسان من خلالها أن يصبح أبًا بمفرده، أو أمًا بمفردها!
وإن كان هذا هو الشكل الغالب لتفتيت الأسرة، بل والقضاء تمامًا عليها، في الدول المسماة بالدول المتقدمة، فإن الدول المتخلفة المقابلة لها تعاني هي الأخرى من الانهيار المتزايد لمؤسسة الأسرة، ولكن لأسباب مختلفة –حتى الآن- ومنها الفقر المدقع –ماديًا وأخلاقيًا- الذي يضيق تمامًا من فرص الزواج لعدم استطاعة الشباب “الباءة”، كما يزيد من المشكلات المؤدية للطلاق، والذي زاد بنسب مخيفة جدًا تصل إلى حد الستين بالمائة من حالات الزواج، ناهيك عن العزوف عن الزواج لأسباب مختلفة ليس هذا هو مجال تفصيلها.
إقرأ أيضا:حماية البيئة مِن محَاسِنِ الإسلامِ ورَوعَتِهويفقد معظم البشر حرياتهم مع الوقت، ويعيشون أسرى لأهوائهم أو لأهواء أقليات من الطبقات السياسية والاقتصادية تتحكم في مصائر الناس وفي رغباتهم وعقولهم، عبر أدوات القمع المخيفة (وخاصة في جمهوريات الاستبداد المسماة بحق “جمهوريات الخوف”، لاسيما في عالمنا العربي والإسلامي)، أو من خلال التضليل الإعلامي المتواصل، القائم على تزييف الحقائق، أو ما يسميه الكذابون الآن بتسميات رقيقة، غير صادمة، ومنها: “الحقائق البديلة”!
كما أن إنسان هذا العصر يفقد في كل لحظة المزيد من الأمان الأخلاقي والقيمي، فالأخلاق هي الأخرى تتعرض لحرب عالمية أشد فتكًا مما عداها من الحروب، حيث يجري تحويلها –على قدم وساق- من الصلابة إلى السيولة، ومن الديمومة إلى النسبية، ومن الفعالية إلى الخمول، ومن السعة إلى الضيق، وباتت كل مرجعية داعمة للقيم الفاضلة عرضة لهجوم ضارٍ وشرس يريد أن يقتلعها جميعًا من جذورها.
ولم يفلح العلم المادي في انتشال الإنسان من هاوية السقوط الأخلاقي والقيمي، بل وأوشكت أن تتحقق بشأنه نبوءة الكاتب الإنجليزي ألدوس هكسلي في روايته المشهورة: “عالم جديد شجاع” التي كتبها سنة 1932م، وتنبأ فيها بأن يقود العلم الحديث الإنسان إلى الشقاء، لا إلى السعادة!
ويكفي للدلالة على إسهام العلم في نزع الأمان من الإنسان، خاصة مع فقدان الأخلاق، أن الناس الآن -في كثير من بلدان العالم- لم تعد تأمن حتى على أطفالها من الخطف أحياء، لبيع أعضائهم الجسدية –بعد قتلهم- لمن يدفع أكثر، وهي حالات من المتوقع أن تتزايد مع الوقت للأسف الشديد، لا بشأن الأطفال وحدهم، بل بشأن البشر عمومًا، وخاصة الفقراء منهم!
إقرأ أيضا:العمارة الإسلامية في الأندلس.. إبداعُ الجمالِ والجلالوهذا مثال واحد على كيفية استخدام البشرية للعلم فيما يضرها، لفقدانها عقلها، وتضييعها للبوصلة الأخلاقية التي تعصمها من السقوط، حيث لا مجال الآن للحديث باستفاضة –مثلا- عن إفسادها (العلمي!) للبيئة، إلى الحد الذي يهدد الحياة على الأرض بالفناء!
هذا الفقدان المتراكم للأمان هو الذي يجعل من عالمنا المعاصر بيئة خصبة للكذب خوفًا وطمعًا من إنسان تنتزع منه روحه وأخلاقه وقيمه، ويُضلل عقله بالأكاذيب ليل نهار، ويَتعرض لإغراءات لا حصر لها تعمل بجد على إشغاله بإشباع حاجياته الفردية الجسدية والمادية وحدها، بعد أن أسقطت –تباعًا- حصونه الأخلاقية والعقلانية الرشيدة، فلم يبق أمامه إلا الكذب يتحصن به ضد كل التهديدات المحيطة به، وهو حصن وهمي كاذب، من شأنه أن يوقعه في الفجور الذي يهدي إلى النار، في الدنيا والآخرة!
ومن المحزن أن المرجعية الإسلامية التي من شأنها أن توفر للإنسان الهدى والرشاد، وتخلق له المناعة اللازمة التي تمكنه من مقاومة ما يتعرض من حرب إبادة لإنسانيته، تعاني من المحاربة والإقصاء والتشويه، وخاصة على مستوى مقاصدها وقيمها، بل وعلى مستوى مصدريها الرئيسين؛ القرآن الكريم والسنة النبوية، ليتحقق فينا ما استعرضه الإمام ابن قيم الجوزية من قبل (بشأن عصره هو، فما بالك بعصرنا نحن) وذلك حين كتب يقول: “لمَّا أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما (…) عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم وظلمة في قلوبهم وكدر في أفهامهم ومحق في عقولهم، وعمتهم هذه الأمور وغلبت عليهم حتى ربي فيها الصغير وهرم عليها الكبير، فلم يروها مكرا، فجاءتهم دولة أخرى قامت فيها البدع مقام السنن، والنفس مقام العقل، والهوى مقام الرشد، والظلال مقام الهدى، والمنكر مقام المعروف، والجهل مقام العلم، والرياء مقام الإخلاص، والباطل مقام الحق، والكذب مقام الصدق، والمداهنة مقام النصيحة، والظلم مقام العدل، فصارت الدولة والغلبة لهذه الأمور…” (الفوائد، ص 48-49).
وهو أمر يدفعنا للتوقف أمام ما خسره العالم بفقدان المسلمين للصدق، وخاصة لتصديق إيمانهم بالعمل الصالح، وذلك في المقال المقبل!